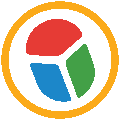- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
كانت الساعة السابعة مساء، تقريبًا، من يوم 11 فبراير لعام 2011، عندما وقفت في بلكونة حزب التجمع في وسط البلد، لأشاهد الحشود التي تحتفل بخلع حسني مبارك.
حشود في البلكونات تطل على حشود في ميدان طلعت حرب، هي امتداد لحشود فاض بها ميدان التحرير والشوارع المتفرعة منه كأشعة الشمس. تمثال طلعت حرب يحمل على كتفيه أحفاداً فرغوا للتو من كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم، سيسمونه "حلم الحرية".
وكل هؤلاء، في البلكونات أو الشوارع والميادين، أو على أسقف السيارات المارة بصعوبة بين الحشود، هم أنفسهم "الولاد، السمر الشداد" الذين تعنيهم الأغنية. لا أحد يستطيع أن يتبين ملامح أحد في تلك الصورة، التي لا يبدو منها إلا أعلام ترفرف، وصوت شادية الحريري يغني للجميع: "يا حبيبتي يا مصر"، ومصر التي ترقص في أجساد أبنائها.
لصوت شادية رائحة لا يخطئها قلبي أبدا، تلك الرائحة التي اعتدت أن أشمّها لسنوات كلما أدرت سيارتي، فانطلق صوتها من الكاسيت، ليغني: "شباكنا ستايره حرير"، تلك الرائحة التي أشمها ولا أستطيع أن أصفها، لكنها باختصار رائحة أيامي كلها، وموجز تاريخ حياتي منذ طفولتي إلى كهولتي. في الحب كما في الثورة، كانت شادية حاضرة، في الفرح وفي الحزن، في الحب وفي الغضب من الحب، ذلك الغضب الذي نسميه- في وقته- كراهية، على غير ما نقصد بالطبع.
عرفت شادية للمرة الأولى في أفلامها مع إسماعيل يس، عندما كنت طفلا، فشكلت صورة الحب الطفولي لابنة الجيران الشقية الخفيفة المرحة التي نتمنى أن نكبر معها، لكننا لا نجدها هي نفسها عندما نكبر، بل نجدها في كل امرأة نحبها في كل مرحلة من مراحل حياتنا.
وأنت تنتظر حبيبتك، تنسى اسمك أحيانا في دوامة الانتظار، لكنك تسمع شادية تغني لك: "سونة يا سونسون جيت لك أهو"، وأنت متأكد تماما أن اسمك لا يحمل أية أصوات من المحتمل أن تحوله إلى "سونة" أو "سونسون". هذا هو صوت شادية الذي يحول كل ما هو ليس لك إلى حالة تحس بأنها تخصك وحدك.
تستطيع أن تستعير صوت شادية لتدندن بشجن صعيدي محب، فارقته حبيبته، أو خاصمته، وهو غير مصدق: "قال لي الوداع، الوداع قال لي". لن تجدها في الحب فقط، بل في لحظات الزهو الوطني أيضا، وهي تغني لك: "يا أم الصابرين ع الألم عدينا"، أو "يا اللي من البحيرة ويا اللي من آخر الصعيد"، وتسمعها تغني لك في غربتك: "خايفة لما تسافر للبلد البعيد"، أو قولوا لعين الشمس ما تحماشي".
وأنا مثلكم تماما، أحببت شادية الممثلة العبقرية التي كانت تدرك بوعي حاد ما يفصل بين كونها مغنية وكونها ممثلة، فشاركت في أفلام لم تغنّ فيها أغنية واحدة. أنا مثلكم تماما، أحببت شخصية حميدة المتمردة في فيلم "زقاق المدق"، حميدة التي صاغها نجيب محفوظ بمصرية صميمة، لكنها التقت في تمردها مع شخصية "نورا" في مسرحية النرويجي هنريك إبسن "بيت الدمية"، حميدة التي تعرفها وتقابلها يوميا في حارتك، البنت الفائرة التي تتمناها في مراهقتك، لكن تهرب من محبتها، لأنك لست شجاعا بما يكفي لاحتمال تمردها، هذه البنت لا يمكنك أن تتخيلها في صورة أخرى غير صورة شادية. وأنا وأنت لم نحب حميدة فقط، لكننا يجب أن نعترف بأننا عشقنا نور فتاة الليل في "اللص والكلاب". علينا أن نعترف بأننا أحببنا نور، وتمنينا أن نجد حبيبة مثلها تحبنا لوجه الحب، تحبنا لأننا ما نحن عليه، أو تحبنا "برغم ما نحن عليه"، نحبها، ولكننا لن نكون قادرين على الاستمرار في محبتها، لمجرد أنها "فتاة ليل" متجاهلين حقيقة كوننا لصوصاً في إحدى صورنا، أو كلاباً في صور أخرى.
دفنّـا شادية في تراب مصر التي أحبتها، لكننا في الحقيقة دفنّـاها في قلوبنا، حيث ترقد بسلام في كل أحاسيسنا، إلى أن نلحق بها في ذلك التراب الدافئ الثقيل.
إعلان