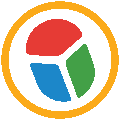- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
بقلم - محمد أحمد فؤاد:
مرة أخرى بعد هدنة أعتبرها قصيرة نوعاً، عادت للساحة سلسلة مواجهات تبدو لوهلة ثيوقراطية النزعة وتتسم بالحدة، لكنها في المقام الأول تأتي كنتاج لموروث اجتماعي بغيض لا يخلو من العنصرية والطبقية إن صح القول.. وأجدها لشديد الدهشة تتراوح بين مكيالين اعتدنا استخدامهما مؤخراً هم ثنائيات التفكير والتكفير، والقبول والرفض، والتأييد والمعارضة في زمن ربما كانت سمته الغالبة هي غياب العقل والقانون أمام سيطرة وإغراء المادة وتداخل المصالح.. وقد وصل الأمر إلى حافة منحدر شديدة الخطورة ربما تتداعى أمامه ثوابت مغلوطة عاشت معنا لعقود طويلة بسبب عدم التطرق لها بشكل موضوعي ومحايد، على شاكلة تصنيف مصادر التشريع بين ما يصلح وما لا يصلح، وكأننا نفاجئ اليوم بوجودها كمجموعة نصوص بشرية الصنع تم ادراجها عنوة لتكون نواة أنماط سلوكية همجية ومناهج فقهية أصبحت مع الأسف عنواناً للتشدد والتعصب.. و كالعادة تأتي الدهشة من جانب التوقيت العبقري لإثارة مثل تلك الأمور والانخراط في خلاف فقهي بشأنها وحول المسئولية عنها وتبعاتها.. بالطبع في غياب تام وأظنه متعمد لسلطات الدولة المنوطة بالتصدي قانوناً لمثل تلك الأمور.
هجوم ضاري يبدو مبرر من جانب من يدَّعون رفض العنف والدموية والخطاب المتشدد المحرض على الكراهية ورفض الأخر.. وكما اسلفت أحسبه "هجوم مبرر"، لكن أود أن أضيف أيضاً أن أغلب من يتبنوا هذا الهجوم ما هم إلا ثُلة من مرتزقة مأجورين اعتادوا الصيد في الماء العكر واثارة الفتن لا عن وعي وادراك وبلا أدنى دافع وطني، لكن بمقابل معلوم، وعن كراهية متأصلة داخلهم.. فبينهم من تركوا بلادهم ليس بحثاً عن الحرية الحقيقية، ولكنهم غادروها كارهين لها ولكل ما فيها، ومثل هؤلاء يتحينوا فرص مهاجمتها كلما سمحت لهم الظروف، ويحضرني هنا للاستدلال هذا المشهد المثير للاشمئزاز من تظاهرات فئة ضالة من أقباط المهجر في واشنطن منذ أيام قليلة مضت بسبب أحداث تبدو طائفية في ظاهرها..!.
الهدف من تلك السطور ليس افتعال أزمة أو تأجيج نيران الخلاف بين طرف وأخر، ولا حتى قياس مقدار التقوى والورع في قلوب البشر على اختلاف معتقداتهم.. لكن هي محاولة بسيطة لوضع بضع نقاط هامة فوق حروف بعثرتها مع الأسف أيادي العبث التي تدعي القداسة حتى صارت حواراتنا وخلافاتنا الفكرية مجال خصب للاحتراب والتراشق والتكفير، وليس مساحة للحوار بهدف المعرفة والتوعية وتقريب وجهات النظر.. لذا دعونا نحصر أولاً حدود المسئولية عن هذه الصورة العبثية باقتدار، ثم لنحاول رصد علاج مناسب لها لعلنا نتدارك تبعاتها السيئة قبل أن تستفحل، أو أن ننقرض نحن من فرط النزاعات وتندثر معنا بقايا حضارات صنعها الأجداد بالعقل أولاً قبل أي شيء.
أبدأ هنا من اعتقادي الراسخ بأن الله لم يعطنا عقولاً للزينة أو لتتبع الأثر.. وهو حتماً لم يعطنا شرائع مخالفة لمنطق البشرية الذي هو التعايش والإصلاح في الأرض..! ومن هنا تقتضي الحكمة النظر للأشياء بحسب ما يتفق وطبيعة البرهان.. وعلى هذا فسأظن بمن ينادي بوجود فوارق عنصرية أو عرقية أو إنسانية بين البشر بأنه شخص مغرض يسعى إلى مآرب خاصة قد تساهم في ظهور انقسامات وخلافات وشقاق يصعب معه تحقيق أي تنمية مجتمعية داخل أي كيان يدعي اعتناق مبدأ التعددية.. الأمر لا يستثني أحداً، وأخص بالذكر هنا أصحاب النظريات المختلفة في تأويل ما جاء من الشرائع السماوية التي أجمعت على الإيمان بوجود الله وحضت على نبذ الشر وإفشاء الخير.
رجال الدين على مدار التاريخ منهم من اجتهد وأصاب وزهد في مغريات الدنيا، وهم قلائل مع الأسف.. ومنهم أيضاً من قلب الأوضاع وطوع النصوص المقدسة لخدمة الحكام أو للحصول على مقابل ما دون أدنى ضمير.. وهؤلاء أحسبهم مؤسسي أوكار الفساد المجتمعي في كل العصور، وهم من أمسكوا بسوط التكفير وزرعوا بذور الخوف من التفكير في قلوب العوام حتى أصبح البعض لا يستطيع قضاء حاجة ما إلا من خلال نص شرعي يعطيه أحدهم بمقابل معلوم..! الأمر تعدى ذلك وأصبح من يطلقون على أنفسهم "كبار العلماء" داخل المؤسسات الدينية يفصلون في الخلافات الاجتماعية والسياسية لصالح الحاكم كونه ولي الأمر وممثل الذات الإلهية على الأرض..!.
وعلى نفس النمط المختل داخل المؤسسات الدينية، نجد الأمر أكثر تفاقماً لدى الأجهزة الرسمية في الدولة، والمنوطة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة بحسب ما يكفله الدستور.. جرى العرف أن تتعامل تلك الأجهزة بتباطؤ وعلى استحياء مع النزاعات الطائفية التي تظهر على السطح من وقت إلى أخر.. وبالرغم من ثبوت ضعف تأثير هذا النوع من الفتن على المجتمع المصري تحديداً، إلا أن أسلوب معالجتها من قبل الأجهزة الرسمية هو دائماً مثير للشفقة والدهشة معاً.. فتكتفي الأجهزة الأمنية مثلاً بالظهور بعد استفحال الجريمة وسقوط ضحايا، ثم يتبع ذلك جمع أطراف من المتنازعين لعقد مجالس عرفية لتحقيق مصالحة أو تراضي من نوع رخيص لا يقطع دابر الفتنة.. أين قوة القانون الرادعة إذاً..؟ ولماذا يتم الالتفاف على تلك السلطة الأكثر أهمية خصوصاً في مجتمعات اعتادت النزعة القبلية في تصريف أمورها كصعيد مصر مثلاً..!.
لم يستوعب فكر رجال السلطة حتى الأن أن الاعتداءات المتكررة بين الأسر المصرية تشوبه ملامح الاستضعاف واستعراض القوة وتجاهل سلطة القانون والدولة سواء جاء هذا في صورة طرد أسرة أو الانتقام لفتاه أو خلاف على أحقية ملكية أو الاعتراض على بناء دار عبادة.. الأمر هنا أخطر من أن يتم اختزاله في كلمة "الوحدة الوطنية" التي ربما أصبحت مجرد نكتة لا معنى لها.. فالوحدة الوطنية لا تتحقق بالشعارات، لكنها تحتاج لقانون يحميها ويرسخ لها دون أدنى تمييز، وهي لا تحتاج بالضرورة لعناق شيخ وقسيس في صورة تتداولها الصفحات والشاشات جنباً إلى جنب مع صور الاقتتال والاحتراب ذو الخلفية العنصرية البغيضة.
وأد العنصرية والفتنة لا يحتاج لخطاب ديني من صنع بشر يدعون القداسة، بينما أغلبهم يتم تعينه بالأمر المباشر من رأس السلطة.. لكنه يتأتى فقط بتطبيق عادل لا تنقصه الصرامة للقانون.. فالأصل في الأديان والمعتقدات السوية معلوم بالضرورة، وهو عدم الميل لفرض الرأي أو المعتقد على الغير، وكذا ضرورة اعتماد منهج الإقناع بالحوار.. لهذا على رجال الدين ممن يخدمون في بلاط السلطة الامتناع عن تلك الميوعة التي أظنها أتت على كل ما لهم من مصداقية.. فقد سئمت الأجيال الحديثة لغة الخطاب الناعم كالحرباء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.. فهؤلاء يبحثون عن منطق عقلاني سليم يستخدم لغة العقل التي تتناسب مع معطيات الحداثة والتجديد، وليس تجديد الخطاب الديني بتغيير ألوان الكتب واستخدام نفس النصوص العقيمة بتطبيقات إلكترونية حديثة.
نحن على أعتاب مرحلة تستوجب بالضرورة تطبيق الدستور حرفياً وبكامل بنوده لرفع الحرج عن أجهزة الدولة.. وأيضاً تتطلب تطبيق القانون بصرامة وبلا أدنى خوف من سطوة مال أو أشخاص.. وهنا لا مجال لمراهقة أو استغلال أو تواطؤ من أي طرف من أطراف منظومة المجتمع إن شئنا تحقيق نهضة شاملة ورسم صورة نموذجية لدولة مدنية حديثة..!
إعلان