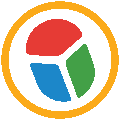- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
في مُفتتح كتابها "المبتسرون" الذي سجلت فيه الراحلة أروى صالح سيرتها الذاتية، وسيرة الحركة الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وسيرة أحلامهم الوطنية والشخصية المجهضة، توقفت كثيراً عند قولها: "إنها شعرت بعد سنوات من تلك الفاعليات والأنشطة بغربة عن الهموم الوطنية ".
وهذا يعني أنها شعرت بغربة عن زمانها ومكانها، وبإحساس بالعبث وفقدان المعنى ولاجدوى الاهتمام بالشأن العام ومتابعة الأحلام الوطنية، وكل ما كان قوام وجودها وحياتها.
ولهذا كان من المفهوم عندئذ أن تضع أروى صالح كلمة النهاية لحياتها بنفسها، بعد أن عجزت عن نقد ذاتها وتجربتها والاستفادة منها، كما عجزت عن التعايش مع متغيرات وتحولات زمانها، ليكون انتحارها شاهدا على هزيمتها النفسية وخيبة أملها، وشهادة على عصرها وتحولاته وهزائمه.
بعد ذلك رحت أقارن حال ومصير أروى صالح، بحال ومصير المثقفين المنتمين الملتزمين من جيل الستينيات، بعد هزيمة يونيو 1967، الذين أطاحت الهزيمة بأحلامهم الوطنية والشخصية.
وقد جسّد قصتهم ببراعة الراحل الأستاذ بهاء طاهر في روايته "الحب في المنفى"، من خلال بطل الرواية المصري المهاجر بعد طوفان التحولات في مصر السبعينات، إلى إحدى مدن الشمال الأوربي، وكذلك صديقه الهارب مثله من هزائمه الشخصية والوطنية، والمقيم في بيروت.
في الرواية نجد البطل الراوي يصف حاله وحال صديقه فيقول: "هو مثلي يتشبث بيقينه لكي لا ينتهي عالمه، لكي لا يسقط حلم دفعنا فيه ثمنا عمرا بأكمله".
وهذا يعني أنهما معًا مارسا شكلاً من أشكال خداع الذات، والعيش في الأوهام، عوضاً عن نقد الذات والتجربة، ليعرفا حجم الخراب والفشل الذي أصابهما وأسبابه الجوهرية، لعلهما يستدركان على ما فات ويصوبان آخطائهما.
ورُحت بعد ذلك أقارن حكاية ومأزق جيل الستينات والسبعينات، بحكاية ومأزق أبناء الأجيال اللاحقة في مصر وصولًا إلى لحظتنا الراهنة، خاصة بعد التحولات العنيفة التي حدثت في مصر والمنطقة العربية والعالم في الربع قرن الأخير، وهي التحولات التي كادت تغير بالكامل مفهوم الوطن، ووظيفة الدولة، ومعنى وغاية الثقافة، ومعنى ومكانة ووظيف المثقف.
وقد وجدت من خلال تلك المقارنة أن الحال لم يختلف كثيراً، وأن أغلب أبناء تلك الأجيال من المثقفين الملتزمين قد دخلوا مبكرًا في مرحلة فتور الهمة وشيخوخة الفكر والوعي والإرادة، والاحساس باللامبالاة واللاجدوى، وأصبحوا يعيشون في منطقة العدمية التي تتماس فيها البدايات والنهايات.
وهذا يعني أن مأزق المثقف الملتزم في بلادنا عابر للأجيال، وهو الذي يجعل المثقف مغترباً ومهزومًا وقوة غير فاعلة أو مؤثرة في المجتمع.
والمثقف الملتزم الذي أتحدث عنه ليس هو الإنسان المتعلم، أو الذي حصل على أعلى الشهادات والدرجات العلمية، بل الإنسان المتعلم الذي يحمل وعيًا تاريخيًا وسياسيًا واجتماعيًا نقديًا، ويتحمل مسؤوليته تجاه مجتمعه ووطنه، ويحرص على أن يدلي بدلوه في الشأن العام، وأن يُعلن على الملأ آراءه حول المجتمع والدولة اللذين يعيش فيهما.
وأظن أن الخطوة الأولى في نجاحه مستقبلًا في القيام بذلك، هو أن يستفيد من تجارب الأجيال الماضية، وأن يمارس أكبر قدر من نقد الذات والتجربة بعد الهزائم التي منيت بها أحلام المثقفين الوطنيين الملتزمين، وأن يحاول تجديد فكره وخطابه، وفهم المتغيرات التي حدثت في عصره، وفي وعي وفكر الجمهور المتلقي لخطابه.
وبدون هذا النقد الذاتي بعد كل تلك الهزائم، سوف يظل المثقف في بلادنا صارخًا في البرية، وسوف يصبح شبيهًا ببطل الأسطورة اليونانية "سيزيف" في رحلته وجهوده العبثية لرفع الصخرة إلى قمة الجبل دون جدوى أو فائد؛ لأنها تتدحرج منه دائمًا لسفح الجبل من جديد.
إعلان