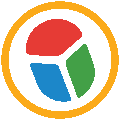- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
ليسمح لي المفكر الكبير والصديق العزيز الدكتور يوسف زيدان بأن أتوازى ولا أتقاطع معه فيما يكتبه في الزميلة (المصري اليوم) تحت عنوان (موانع التقدم) لاسيما ثالث مقالة له في سلسلة (موانع التقدم: اعتقاد اللاجدوى).. ففي ظني أن الرجل الحالم بجرأة قد نكأ جرحاً غائراً بداخل كل الحالمين وجُل المحبطين واليائسين.. إذ أن (التقدم) في سيرة ومسيرة المصريين يبدو دوماً شعاراً للتوظيف السياسي والحشد الشعبي أكثر منه هدفاً وطنياً يسعى أي نظام حاكم لبلوغه أو حتى مجرد البدء على استحياء في طريق إليه..!
ولأنني لست باحثًا فذاً في الأثر والتاريخ ولا فيلسوفاً أو روائياً مثل (زيدان).. فسوف أعلق على بحثه في أسباب التخلف و(موانع التقدم) من وجهة نظري وواقع مصر خلال النصف قرن الأخير، خصوصاً أن الدكتور يقول في مقالته: (وقد ظهر لي بعد قليل من النظر في أحوالنا العامة منذ منتصف القرن الماضي، أن الشعور باللاجدوى كان من أهم عوامل التثبيط العام الذي أدى للتدهور الشديد في بلادنا).. ودون مواربة أو التفاف يقصد (زيدان) ما حدث منذ ثورة يوليو ١٩٥٢.. وهي اللحظة التي يمكننا البناء عليها في تحليل واقعنا الراهن، ليس لإثارة جدل بلا طائل ولا لإلقاء المسئولية على طرف دون آخر.. وإنما لأنها كانت نقطة تحول كبرى في فلسفة الدولة المصرية وقواعد وأسس تكوين وتشكيل الإنسان المصري المعاصر..!
وإذا اتفقنا أن الشعب المصري بصفوته ومبدعيه وعوامه في الخمسينيات والستينيات وحتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي كان نتاجاً لنصف القرن الأول.. أي أنه تشكل عقلاً ووجداناً في فترة الملكية، فأبدع ونضج بعد ذلك.. فإن المنطق يحتم علينا الاعتراف بأن الإنسان الذي صنع المشهد الحالي ولِد وتربى وتعلم في الفترة ما بعد ١٩٥٢.. إذ بلغ من ولِد ليلة ٢٣ يوليو من ذاك العام ٦٥ عاماً اليوم.. وبالتالي فهو ثمرة طبيعية - بحلوه ومره – للدولة أو الجمهورية الأولى التي تأسست في تلك الليلة الفارقة..!
هذا الإنسان لم يصل يادكتور زيدان إلى التسليم باللاجدوى دون مروره بمراحل عدة، انحدرت به من موقع الفاعل إلى المفعول به، ثم اللامكترث واللامنتمي أصلاً، فقد عمدت السلطة الحاكمة عن وعي تام إلى (اللاجودة) في كل مناحي الحياة، عبر تعاقد غير مكتوب مع المواطنين ينص على أن يتنازل الشعب عن المشاركة في الحكم بل ومجرد اختيار من يحكمه، مقابل حصوله على الحد الأدنى من متطلبات الحياة ، وبالتالي التعايش التام مع (اللاجدوى) .. وهو ما تجسد في (مسخ) المجتمع بكافة مستوياته وطبقاته: الكل يلبس من صيدناوي وباتا وعمرأفندي.. الكل يقطن في المساكن الشعبية.. والكل يقف في الطابور للحصول على (فرخة مجمدة وزجاجة زيت وكيس سكر وباكو شاي).. وهكذا لم يعد للعلم قيمة ترتقي بصاحبه.. ولم يصبح للإبداع والابتكار والاجتهاد جدوى.. إذ بات الحصول على درجة علمية رفيعة لايساوي أكثر من ترقية شكلية وعلاوة بضعة جنيهات في وظيفة روتينية لا تقدم ولا تؤخر شيئاً لصاحبها والأمة..!
اللاجودة حكمت كل شئ.. فسادت اللاجدوى كل شئ: مهما اجتهدت وأبدعت لن ترتقي في السلم الاجتماعي ولن تترقى في دولاب الدولة، سوى في تلك المساحة الضيقة التي نسمح لك نحن بها، ما لم يكن لك طريقاً آخر، والطرق الملتوية ليست بحاجة على الإطلاق للإبداع والاجتهاد والابتكار..!
ظلت السلطة الحاكمة على مدى أكثر من نصف قرن تقول للإنسان المصري كل صباح: لا نريد منك جودة.. لا في وظيفتك ولا في دورك الاجتماعي ولا حتى في أحلامك.. سوف تولد لأب مقهور وأم تتحايل على المعايش لتدبر لقمة في حدها الأدنى.. وستنال تعليماً متواضعاً في (الحد الأدنى).. وحين تمرض لن تحصل على ( الحد الأدنى) من الرعاية الصحية.. أحلامك سوف تتآكل تدريجياً أمام عينيك، حتى ترضى وتسعى زاحفاً إلى (الحد الأدنى).. لذا فحينما تصبح موظفاً لا نريد منك في ذات الوقت أكثر من (الحد الأدنى).. وعليه وقع الطرفان العقد، وكلاهما استراح وأراح الآخر..!
اللاجودة واللاجدوى لم يكونا اختياراً شعبياً بقدر ماكانا سياسة اختارتها السلطة الحاكمة وارتضاها المواطن.. فهي تضمن للحاكم بيئة مواتية للانفراد بالحكم وإنساناً طيعاً لا يعرف حقوقه، وإن عرفها أيقن باللاجدوى من المطالبة بها..
وعلى الجانب الآخر فإن تلك الصيغة التعاقدية وفرت للمواطن الارتكان الهادئ للسلبية والجهل والفساد بعلم السلطة ومباركتها.. وبالتالي لم يكن مدهشاً لي وللكثيرين أن يصدر مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠١٧ منذ شهر تقريباً، فتأتي مصر في المركز ١٠٥ بين ١٢٧ دولة، متأخرة عن دول عربية وأفريقية كثيرة.. بل لم يكن مدهشاً أن أكتب عنه هنا مقالة بعد صدوره بأيام دون أن يكترث أو يهتم أحد من الدولة بتلك الكارثة.. وفي ظني أن هذه المفارقة المفزعة إنما تجسد إحساس (اللاجدوى) لدى الدولة نفسها بكافة مؤسساتها وأجهزتها، فما بالنا بالمواطن ذاته؟!..
وهكذا، يبدو أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين (اللاجودة) كأسلوب حياة واختيار دولة، و(اللاجدوى) كمصير حتمي لتراكمات كثيرة تجذرت بعمق في الشخصية المصرية، وفي ظني - يادكتور زيدان - أن إعادة إحياء الجدوى والأمل في النفوس لن يتحقق إلا باعتماد مفهوم الجودة منهجاً للحياة.. ولايزال لدي أمل كبير في تأسيس وتشكيل إنسان مصري جديد يؤمن بالجدوى ويكافح من أجلها..!
إعلان