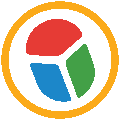- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
ليس بمقدور أحد أن يقدم نقدًا عميقًا للتطرف والتعصب الديني والمذهبي والفكري من غير أن تكون الحياة قد منحته فرصة ثرية للاطلاع على المنتج المعرفي للعرب والمسلمين الأقدمين وما جادت به قرائح الغربيين في الفلسفة والآداب، جامعًا بين تراث وتجديد، وبين أصالة ومعاصرة، مدركًا ما ينبعي له أن يبقى مما تركه الأولون، وما يجب أن ننظر إليه على أنه مجرد جزء من تاريخ العلم والمعرفة، لكن لم يعد علمًا ولا معرفة قابلة للتفاعل مع حياتنا الراهنة وإفادتها، كما يؤمن أتباع الجماعات المتسلفة والتراثية والمتترسة وراء تصورات بشرية متحجرة تضفي عليها قداسة، مع أنها لم تكن سوى إجابات عن أسئلة زمن ولى ولن يعود أبدًا.
والحقيقة أن من يمتلكون هذه الإحاطة في ثقافتنا العربية ليسوا كثيرين، فالأغلب إما مشغول بتراثنا لا يبرحه، متوهمًا أن فيه ما يكفي، وإما عارف بما أنتجه الغرب، متيم به، بعد أن ولى ظهره لما مضى من تراثنا، لا يرى فيه إلا كل نقص وعوار. واحد من هؤلاء الذين اطلعوا على عطاء الثقافتين هو الناقد الكبير د. صلاح فضل، وهو أمر إن كان قد بان للجميع في نحو أربعين كتابًا قد ألفها، وخمسة قد ترجمها عن الإسبانية، ومئات المقالات والدراسات، فإنه أتى على ذكره بوضوح، وكشف ملامحه وجوانبه الخفية في مقاطع من سيرته الفكرية التي أصدرها مؤخرًا تحت عنوان "عين النقد".
فهذه السيرة الثرية لا يبين فيها فقط علاقته بقامات كبرى في ثقافتنا العربية مثل طه حسين وتوفيق الحكيم ولويس عوض وإحسان عبد القدوس، إنما يدلي برأيه في أشياء كثيرة في حياتنا المعاصرة، بدءًا من الانشغال بكرة القدم ونهاية بالتسلط السياسي، والفساد الاجتماعي، مرورًا بحديث عن النقد ومدارسه، والشعر واتجاهاته، والرواية وأصنافها، والصورة وأبعادها، والجوائز وخلفياتها، وما جرى لجامعاتنا، وحتى شكل العمران وهندسته، من خلال تجربته مع صاحب عمارة الفقراء المهندس العبقري حسن فتحي.
تأخذ هذه السيرة شكلاً مختلفًا عن كثير من بنات نوعها، ولذا يمكن قراءتها من زوايا عدة، مثل حال الثقافة المصرية في نصف القرن، وتجربة ذاتية في النقد الأدبي، ومآل الرغبة في التميز والتفرد، وتناول هذا يحتاج إلى مقالات عديدة، لكنني اخترت زاوية أخرى، نبدو أكثر احتياجًا لها الآن، وهي جدل التعليم المدني والديني، وسبل صناعة عقل متسامح مع الآخر بعد هضم ثقافته، وإدراك أهمية الإيمان بالتنوع البشري الخلاق.
فالدكتور صلاح فضل أُبتعث إلى إسبانيا للدراسة، ثم عاد إليها فيما بعد مستشارًا ثقافيًا للسفارة المصرية، فواتته فرصة الاطلاع على الأدب الإسباني في موطنه وفي قارة أمريكا اللاتينية برمتها، وكذلك ما يُترجم إلى الإسبانية بانتظام من كتب صدرت بالإنجليزية وفرنسية في نظريات الأدب واتجاهاته، فتلقى كل هذا وهو الأزهري الذي انتقل إلى دار العلوم، وابن الريف الذي جاء إلى المدينة، والشرقي الذي ذهب إلى الغرب، فتفاعلت في رأسه الثقافات النابتة في بيئات اجتماعية وحضارية مختلفة، واختلطت وامتزجت أحيانًا، فبدا ذهنه أشبه بمعدة النعام، الذي يلتهم أشياء متنافرة، لكنه يهضمها ويحولها إلى عصارة سلسلة مفيدة.
وما هضمه صلاح فضل على ضخامته، خرج سلسًا، ليس على مستوى أسلوبه الفياض الجلي، إنما وبالأساس في الفكرة المركزية التي تُستنبط من كل ما ذكره في كتابه على تنوعه وامتداده في مدى زمني طويل، وهي رفض التعصب، والتصدي لثقافة الكراهية، والحرص على مصاحبة الكبار دون الوقوع في فخ تقديس شخص أو رأي بشري، والنظر إلى الإيجابي في كل الذين نقابلهم، ونتعامل معهم، والسعي وراء الهدف بلا كلل ولا ملل.
إن تجربة صلاح فضل في النقد والحركة الاجتماعية والسياسية والتدريس، ربما تكون محل أخذ ورد واتفاق واختلاف بين كثيرين، لكنها لا تخلو من اتفاقهم جميعًا على اعتقاده الجازم الحاسم في الثقافة المدنية، وإيمانه بضرورة إصلاح المؤسسات الدينية من داخلها وخارجها في آن، وأهمية انفتاح العقل العربي على الثقافة الإنسانية بلا سد ولا حد، دون النظر باستعلاء إلى تراثنا الشرقي في شتى صوره وطبقاته الحضارية.
ويمكنني في هذا المقام أن أقول أيضًا إنه كثيرًا من الآراء والتصورات والأفكار التي أطلقت حول التسامح والتعايش لم تعرج على الأدب حاملًا لهاتين القيمتين العظميين، ليس قطعًا بطريقة مباشرة، كالتي نسمعها من على منابر الخطب أو في تصريحات الساسة، إنما عبر مسار يخضع لشروط الفن في الشكل، بينما يكون مضمونه غير المباشر حاملاً وحافلاً بما يعزز الحوار وقبول الآخر والاقتناع بجدوى تعدد الثقافات والتنوع البشري الخلاق، سواء فيما يرد على ألسنة الشخصيات الروائية أو ما يبثه الراوي أو السارد من أفكار في ثنايا النص.
أعتقد أن من الروايات التي تحقق هذا باقتدار تلك التي كتبها الكاتب المصري الموهوب سعد القرش تحت عنوان: "المايسترو" والصادرة عن "دار العين" بالقاهرة، والتي احتاج إلى قراءة مصادر معتبرة في نصوص مختلف الأديان وفلسفاتها وتصورات أتباعها، حتى يكون بوسعه أن يقيم حوارًا عميقًا بين ممثلين للمعتقد الإسلامي والمسيحي والبوذي وبعض أديان شرق آسيا، ويدعهم يتحدثون بحرية، ووفق ما يسعفه الجنان واللسان لكل منهم، فيخرجون، وهو معهم بصناعة سياق متماسك يحمل على كتفه حكاية شيقة، تنتقل بنا مكانًا من الخليج العربي إلى وادي النيل ثم جبال التبت ومروج الهند وعبر التواصل الإلكتروني تأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتغدو وتروح بنا زمانًا بين ماضي ولى وحاضر يقيم ومستقبل متوقع؛ لتقدم لنا أمثلة وحكايات ودلائل تعزز التسامح بين البشر على اختلاف العقائد والمذاهب والطبقات والجهات واللغات واللهجات.
حتى المسار الغرائزي أو الشهواني في الرواية يرمي بطريقة غير مباشرة إلى خدمة الفكرة المركزية لها، حين يلعب دورًا في تذويب الفوارق بين المختلفين طبقيًا وثقافيًا وعمريًا، ليصفوا احتياجًا إنسانيًا مشتركًا بوسعه أن يفعل هذا، مثلما سبق أن تنبأ الطيب صالح في رائعته: "موسم الهجرة إلى الشمال"، حيث كان بطله يتوقع أن يتسبب هذا المسار في فتح أوروبا بأسرها أمام الأفارقة.
لم يطرح "القرش" الأمر بهذا التصريح المباشر، إنما ترك العلاقة بين أبطاله تنبني على إقناع ومودة، بعيدًا عن التصورات المعلبة والخطابات الزاعقة التي تطالب، في إلحاح، بحوار الثقافات والحوارات. فما يدور من سجالٍ هنا سواء على سطح قارب بسيط يمضي بين اليخوت الفارهة في الخليج بين شباب ينتمون إلى دول وأديان عدة، أو على البريد الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بين شاب مصري وامرأة أمريكية، أو عبر النقولات والاقتباسات والإحالات التي يدمجها الكاتب في نصه بنعومة شديدة، صانعًا منها -وفي اقتدار- سبيكة واحدة تقول: "كلنا واحد وإن اختلفنا".
هذه الرواية تبرهن -بحق- على أن الأدب بوسعه أن يؤدي ما ليس لغيره أن يفعله حيال قضية التسامح والتعايش، فالنداءات التي جاءت في ركاب هذا أتت جلها من علٍ، فكانت قضية حكومات أو نخب فكرية، بينما هنا في هذه الرواية، وهي مثال لما يمكن للأدب أن يقوم به، يجري النقاش حول هذه القضية، وبطريقة غير مباشرة، بين شخصيات تقع على هامش المجتمع، لكنها في النهاية تمثل كل أولئك الذين إما أن يقوم على أكتفاهم أي حديث نخبوي عن التسامح، أو ينهدم وينقض بشكل جارح وبارح.
كان الكاتب نفسه، بما هو مقتنع به من أفكار، وراء أبطال روايته، يمدهم بما تيسر له من قراءات متعددة في مختلف الاعتقادات والثقافات، لكنه لا يضع الكلام على ألسنتهم، إنما يترك لكل منهم حرية التعبير عما يريد، ولكي يخليهم من قيود وقواعد مفروضة على الخدم والعاملين لدى الغير والسياح غير المقيمين، جعلهم يلتقون في طقس يحررهم من كل حسابات، حيث يتحلقون حول النبيذ فوق مركب صغير ضائع. وكأنه يقول إن القيود والكوابح التي تكبل الإنسانية وتمنع كل فرد من قبول كل مختلف عنه هي بنت الوعي المريض الذي غذته ثقافات وتجارب تعمق النفور والكراهية؛ ليبقى على الإنسانية أن تكافح بإصرار كي يهل ويحل التسامح مع الوعي واليقظة التامة بعيدًا عن أي مؤثرات للتغييب، ويجد من الأنصار من يدافعون عنه لينقلوه إلى درجة الانصهار التام؛ لتحل السكينة في النفوس، ويخرج العالم من مأزق النبذ والابتعاد الكريه والعنف والتشفي.
إعلان