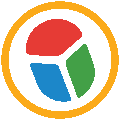- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
- «لقد فقدت إيماني!».
- لكننا سنغلق العيادة؛ فالطبيب على وشك أن يُغادر، فلنحدد موعدًا في الأسبوع القادم.
- لكنني فقدت إيماني وبحاجة للطبيب.
في تلك اللحظة يخرج الطبيب وهو يخلع البالطو الأبيض قائلًا: «لديّ أتوبيس لا بد أن ألحق به ...»
الحوار السابق هو أحد مشاهد فيلم «عن اللانهاية» للمخرج روي أندرسون، صاحب الفيلم الشهير «حمامة تجلس على الغصن تتأمل الوجود»، الذي نال الأسد الذهبي عام ٢٠١٤ بمهرجان فينيسيا في دورته الحادية والسبعين، والذي كان يعتبر «الجزء الثالث من ثلاثية أن تكون إنساناً»- كما كُتب في أعقاب المشهد الأول بالفيلم- وهي الثلاثية التي بدأها المخرج السويدي بفيلم «أغنيات من الطابق الثاني» عام ٢٠٠٠ الذي نال عنه جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الكانيّ، ثم تلاهه بفيلم «أنت... الذي تعيش» عام ٢٠٠٧.
أطراف الحوار السابق قسيس فقد إيمانه، وأصابته حالة من القلق وعدم الاتزان والخوف، قسيس من المفترض أنه يبث الطمأنينة في قلوب الخائفين، ويمنحهم طريق الهداية والسكينة، لكنه صار غير قادر على منح نفسه هذا الدواء.
يلتقي القسيس بطبيبه المعالج، في بداية الفيلم، ويحاول أن يعقد صفقة معه، فكل منهما يحتاج للآخر، فهل حقاً الاحتياج متكافئ؟
المهم أنه عندما يعود القسيس لعيادة الطبيب بعد أن تدهورت حالته في الجزء الأخير من الفيلم تحاول الممرضة تأجيل الموعد للأسبوع التالي، لأن موعد العمل انتهى، والطبيب يريد أن يلحق بالأتوبيس، ثم لا تتورع هي والطبيب عن أن يدفعاه بقسوة للخلف في محاولة لطرده خارج العيادة رغم صرخات الاستغاثة.. مشهد عبثي، لكنه ذو دلالة كبيرة للإنسانية المفقودة في تلك المجتمعات الباردة عاطفياً.
الفيلم به كثير من المناطق التي تُفجر الضحك بالقاعة، رغم البساطة، ورغم أنه لا شيء يحدث. والمؤكد أنه إذا دخلت قاعة العرض لمشاهدة الفيلم السابق، دون أن تعرف أن هذا فيلم من توقيع روي أندرسون، ومن دون أن تقرأ التتر، وكنت قد شاهدت فيلمه السابق «حمامة تجلس على الغصن تتأمل الوجود»، فلا بد أن تعرف أن هذا شريط سينمائي جديد بتوقيع أندرسون. لماذا؟ لأنه ليس فقط الفيلم كفيلمه السابق عبارة عن مشاهد متفرقة، تبدو منفصلة، لا رابط بين أبطالها إلا فيما ندر، باستثناء أنها مشاهد تعبر عن الحياة، لكنها أيضا تبدو ساخرة جداً أحياناً، تجعلنا نضحك أحياناً أخرى، وفي كثير من المرات تمنحنا الفرصة كي نتأمل ونفكر في أحوالنا وما يحدث من حولنا في الحياة، هل نحن نشبه هؤلاء الأبطال؟ أيهما تحديداً؟ وإلى أي درجة؟ وأخيراً هل هناك مفر، أو طريق للعلاج؟
الإنسان يتبدل ولن يختفي
يُواصل روي أندرسون حكاياته التي تبدو متفرقة، بينما هي ليست كذلك، نشاهد شابًا وفتاة يجلسان في غرفة، وأمامهما ميكروسكوب على حامل مرتفع أمام النافذة.
الفتاة شاردة بفكرها تلعب في خصلات شعرها، بينما هو يتصفح كتاباً قبل أن يقول:
- أنتِ طاقة. وأنا طاقة. طاقتك وطاقتي لن تزولا. لن تفنيا، لكنهما ستتبدلان في صورة أخرى. ربما تتحولين إلى حبة بطاطس، أو حبة طماطم.
هنا ترد الفتاة بجدية خالصة: أُفضل أن أكون حبة بطاطس.
قد يبدو الفيلم بسيطا، وهو بالفعل بسيط، لكنه أيضاً عميق جداً، ثري، لن يمنحك أي فرصة للملل مطلقاً، رغم أن بعض المشاهد تبدو محملة بالصمت الطويل، والكلام بها قليل جداً وشحيح، وأحياناً لا شيء يحدث. كل هذا يبدو ظاهرياً، لكن الحقيقة أن المشاهد تتفجر بالمعاني، بالمشاعر بالتوتر والارتباك المكتوم، وتشي بالمأزق الإنساني الذي يمر فيه البشر.
روي أندرسون لديه أسلوبه الخاص في السرد السينمائي، سواء في المونتاج وتركيب المشاهد، وتكوينها الزمني النفسي وبأداء أبطالها الذي يُفجر الضحك في القاعة بين حين وآخر، وذلك رغم أن المشاهد تم تصوير كل منها في لقطة واحدة واسعة، بكاميرا ثابتة ومن دون أن يُسمح للمتلقي بالتورط معها، ولكن فقط تأملها من بعد، كأنها لقاءات مباشرة مع الحياة والموت والحزن والضياع، لكنها لن تكون الأخيرة. فالفيلم بأكمله تنويعات على مواجهة الحياة والقلق الذي يعيشه الأوروبيون، خصوصاً أهل السويد.
روي أندرسون (٧٦ عاماً، العائد بعد غياب خمس سنوات) أخرج فقط ستة أفلام طوال حياته منذ سبعينيات القرن الماضي، بينما أخرج ما يقرب من ٤٠٠ إعلان تجاري للإنفاق على إنتاج أفلامه. وهو في شريطه المُتوج بالأسد الذهبي، وكذلك يفعل بفيلمه الجديد «عن اللانهاية» إذ يرسم أجواءً كابوسية في العمق وبين طبقات ومستويات الضحك والسخرية، فالكوميديا عنده تمتزج بالمرارة، وتكشف عن مأساة الوجود الإنساني. في ظل هذا كله يتميز شريطه السينمائي بالإيقاع الشاعري وكذلك الكوادر بتكويناتها التشكيلية وبأثاثها البسيط المتناثر في الفراغ الذي يشعرنا بالبرودة العاطفية والوحدة الجليدية القاتلة حتى في أكثر الأماكن ثراءً، بإضاءتها الكابية والصفراء الموحية، ليس فقط بالجو الخريفي، ولكن أيضاً بالاحتضار وسيطرة شبح الموت على الأجواء.
بفيلمه الأحدث المعروض ضمن المسابقة الرسمية في موسترا - ويتنافس به أندرسون مع ٢١ فيلما على الأسد الذهبي - سنجد عاشقين محلقين فوق مدينة جميلة كان تم تجديدها لكنها الآن تم تخريبها بفعل الحرب... سنرى شاباً وحيداً لم يعثر على الحب رغم أن هناك فتاة تروي شجرة أوراقها ذابلة تبدو كأنها على طريق الاحتضار، فهل هناك علاقة بين الشاب والشجرة؟
كذلك نرى امرأة شابة تهبط من القطار بحقيبة سفرها فلا تجد أحداً في انتظارها، بينما قبلها بقليل قد هبط رجل وجد في انتظاره دفء الحب الذي غمرته به زوجته وطفلته... سنسمع ونرى رجلاً يبكي في أحد الأتوبيسات المزدحمة وفجأة يقول: «أنا لا أعرف ماذا أريد» ويظل يرددها بشكل هستيري يجعلنا نضحك من تلك الكوميديا السوداء، بينما تنهره فتاة بجواره: «لا يحق لك أن تكون حزينا»، فيرد عليها رجل آخر: «إن لم يكن مسموحاً لنا أن نمارس الحزن في البيت، فما الذي يمنعنا من ممارسته هنا؟».
تتعدد المشاهد عند روي أندرسون كأنها فسيسفاء لخارطة الكون والحياة الإنسانية بالكثير من تعقيداتها، فهناك رجل فقد عنوانه، رجل ضل الطريق، وآخر تخيل أنه سيغزو العالم ثم اكتشف فشله وهزيمته الساحقة، ورغم أن المخرج يتناول الحاضر في فيلمه، فإنه أيضاً يعود إلى الماضي وإلى التاريخ ليشي بأن الحاضر كان ثمناً فادحاً لأخطاء الماضي، فهو مثلاً يلجأ إلى الفلاش باك ليعود صراحة للتاريخ ويقدم لنا شخصيات تُجسد هتلر وجنوده وأوهام هذا الرجل عن غزو العالم، لكنه أيضاً مشهد يحمل إسقاطات على الحاضر، من دون أن يغفل المخرج المؤلف توابع الحرب وآثارها، فهناك أبوان فقدا ابنهما في الحرب، وسيدة انكسر كعب حذائها في الطريق، فاختل توازنها، وعندما خلعته، وسارت حافية أصبحت قادرة على السير، دون أن ينتبه أحد، ثم يختتم المخرج السويدي مشاهده برجل تعطلت سيارته في طريق ممتد بين الحقول خالٍ من البشر، بينما سربٌ من الطيور محلقٌ في السموات يعرف طريقه جيداً.
إنه فيلم عن مأزق الإنسان الوجودي، أو ربما يريد أن يقول إن كل شخص يحمل صليبه.
فهل يمكن لروي أندرسون أن يحصد جائزة جديدة في فينيسيا؟
سؤال يصعب الإجابة عنه؛ لأنه يصعب التنبؤ بتوجهات لجنة التحكيم... لكن الفيلم، من دون شك، يستحق الجائزة.
إعلان