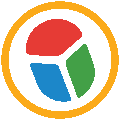- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
تهضم رواية "صلاة خاصة" لصبحي موسى كثيرًا من الوقائع التاريخية، والمعاني الفلسفية، والآراء الدينية، والحمولات النفسية، وتعطيها لقارئها الذي عليه أن يكون منتبها طيلة الوقت وهو يطالعها، وحبذا أن يكون على قدر من المعرفة بالديانة المسيحية في نصها، وطقوسها، وتطورها التاريخي، وتفاعلاتها الاجتماعية التي تراكم بعضها فوق بعض طيلة زمن مديد.
فالرواية التي تقع في نحو خمسمائة وخمسين صفحة من القطع فوق المتوسط تعرض في أقسامها الثلاثة جانبا لا يستهان به من تاريخ التدين المسيحي، ليس في مصر فحسب، إنما خارجها، ذاهبة وراء تنقلات أتباع هذا الدين وأفكاره وتصوراته في العالم، منطلقا من أرض فلسطين إلى مصر والشام، ومنها إلى الإمبراطورية الرومانية، حيث دخل الصراع السياسي على النص الديني، ووقع الخلاف الكبير الذي جسده "مجمع خلقدونية" في أعمق صوره، موزعا الكنيسة إلى أرثوذكسية وملكانية، ليأتي في ركاب هذا اضطهاد الرومان للمسيحيين الشرقيين، واضطهاد الاثنين لأتباع الأديان المصرية القديمة التي كانت تنادي بالتوحيد، وهو ما أدى إلى قتل العلماء والكهنة وحرق كتبهم، الأمر الذي جعل العالم يدخل في ظلام دامس لسبعة قرون تقريبًا.
ولأن الرواية تعرضت لمسألة تقادم عليها الزمن، وتنازعت حولها الرؤى، واحتقنت بشأنها النفوس، وتضاربت المصالح، وتصادمت الأهواء، فإنها أتت على هذه الحالة، تمور برؤى عديدة، دون حسم، وتعرض الآراء دون أي زعم بأنها تجسد اليقين أو تنتصر له، عبر حكاية أثيرة، تنطوي على قصة حب بين الكاهن أنطونيوس، وهو "الجسد الذي يبذل" ويرمز إلى الإخلاص في البحث عن الله والرغبة الدفينة في معرفة الذات والوجود، ومحققة كنيسة تسمى دميانة، وهي "عاصفة الجنون" التي تعطي مثلا عميقا لما يلاقيه الإنسان من قهر وإكراه في الدنيا. ويلتقي في دير ليس على مكان على الأرض، إنما هو من صنع مخيلة الكاتب، سماه "دير الملاح".
وعبر هذه العلاقة التي تتصاعد مع توالي الصفحات ونمو الحكاية، نعرف الكثير عن الدور الذي لعبته الرؤى المصرية القديمة في تشكيل مسار المسيحية، وندرك في الوقت ذاته أن قديم مصر لا يزال حيا، وأن الطبقات الحضارية المصرية المتتابعة هي جزء أصيل من شخصية هذا البلد العريق، وأن "مصر وثيقة من جلد رقيق، الإنجيل مكتوب فيها فوق هيردوت، وفوق ذلك القرآن. وتحت الجميع لا تزال الكتابة القديمة تقرأ بوضوح وجلاء"، كما يقول نيوبري، ويقره إدوارد لين، في دراساته عن شمائل المصريين وعاداتهم، وكذلك دراسات سيد عويس، وسليمان حزين وطاهر عبد الحكيم.
فما كان لسلطان رجال الدين في معابد الفراعنة، انتقل إلى المسيحية، وبغض النظر عن مسار الأديان المتتابع والمتوازي والمتفاعل والمتخاصم، فإن التقاليد الاجتماعية، المستترة في الرواية، يصارع فيها الجديد القديم، ويصطدم المحافظ بذلك الساعي إلى التغيير الجذري، ليبدو أحيانا الزمن دائريا وأحيانا مبعثرا، حيث نشعر أحيانا أننا قد عدنا إلى ما كنا فيه، أو على الأقل، نوقن بأن التقدم إلى الأمام بطيء، وأن جيوب التحديث سرعان ما يتم تطويقها بجدران عالية من الرؤى والتقاليد الموروثة، سواء جاءت من الدين أو من غيره. ربما لهذا تبدو بنية الرواية أقرب إلى الدائرية.
ويبدو أن الكاتب يعتقد أن مسار الخروج من هذه الدائرة أو الهروب من تلك المساحة الراكدة، يتمثل في إقرار التعددية الثقافية والدينية، وداخل الدين الواحد، يقتضي ضرورة الإقرار بتعدد المذاهب والتصورات.
فالرواية فضلا عن توضيحها أثر الحضارة الفرعونية على المسيحية، فإنها تبين كيف كانت الإسكندرية تموج بمدارس فكرية يونانية ورومانية وبقايا الفكر المصري القديم، وكيف أن هذا تفاعل مع المسيحية.
لكن الرواية لم تقتصر على تشريح قديم الكنيسة، إنما أتت على رسم ملامحها في الوقت الحالي، لتبين أن مشكلاتها القديمة لا تزال على حالها، وكأنها منبتة الصلة عن السياقات التي تحيط بها، وما تسرب إليها من تحديث وتمدين.
فالأسئلة القديمة لا تزال تطرح دون إجابات شافية، وإدراك رجال الدين لدورهم لا يزال على حاله، حيث لا يكتفون بكونهم وعاظًا ومرشدين إلى طريق الرب، إنما هم ممثلون للسماء على الأرض، حيث للرهبان والكهنة سلطة واسعة على شعب الكنيسة، وهي مسألة إن كانت تحظى برضاء متفاوت من قبل الكهول والشيوخ فإنها تقابل من بعض الشباب بتذمر صائت قليلا، وصامت كثيرا.
وينتقل الكاتب بين الراهن والقديم، والحالي والراحل، عبر آلية "الاسترجاع"، متخذا مكانا لها في الدير الذي تخيله، وجعله في هضبة البحر الأحمر الآن، والقلزم قديما، وصوره على أنه بقعة يلجأ إليها من يفكرون بشكل مختلف عن كل السائد والمتاح والموجود والمُسلَّم به، ويستنطقون المسكوت عنه، وينبشون في الراكد والمكدس المسربل بالقداسة، والذين شكلوا سلسلة بدأت بالملاح، وأتى بعده ديمتريوس فأبانوب ورفائيل وغيرهم، حيث عكفوا على توضيح الغامض في المخطوطات، وتأويل وتفسير ما يحتاج إلى تبيان.
وتحرك الكاتب من "اللاهوت" إلى "الناسوت" نازعا القداسة التي أُضفيت على بعض البشر من آباء الكنيسة، ومن بينهم أوريجانوس، المتوفى عام 254 م، والذي وضع عبر رسائله كثيرًا من أسس الإيمان المسيحي، واعتبره البعض أمير شُراح الكتاب المقدس، ووصف بأنه "الرجل الفولاذي" لأن حججه كانت قوية لا تضارع، ومع هذا حرمته الكنيسة في حياته، وحرمت الكنائس الخلقدونية أتباعه سنة 553 م.
وأوريجانوس هنا في الرواية ليس شخصا، بقدر ما يشكل رمزا لكل من عاند التصورات السائدة عن طبيعة المسيح وتاريخه، وهو العناد الذي جسده آخرون مثل أريوس، الذي صارع أثناسيوس أتباعه، ووصلت بعض ظلاله إلى زماننا الحديث في الجدل اللاهوتي بين المذاهب المسيحية، وفي تساؤلات الشباب الموجهة للكهنة عن الكثير من هذه التصورات التي تعاملت الأغلبية معها على مر التاريخ على أنها راسخة كالجبال.
وإذا كانت كنيسة الإسكندرية قد انتصرت على من سمتهم الهراطقة من أمثال يوحنا ذهبي الفم ونسطورس وأوطاخي في الزمن القديم، فإنها الآن تؤكد، دون إعلان صارخ، انتصارها على المختلفين معها، والذين تطلق عليهم "علمانيين"، وقد أقدمت على حرمان بعضهم، وقمعت آخرين، ومنعت أفكارهم من الوصول إلى رؤوس الناس، الذين لا يزالون منجذبين إلى عظات الكهنة، معتقدين أن الكنيسة الشرقية ليست في حاجة إلى الإصلاح مثلما جرى في الكنيسة الغربية، وهي مسألة لم تكن بعيدة عن ذهن الكاتب وهو ينسج خيوط روايته تلك.
إن السياحة في هذا التاريخ الطويل والسعي وراء أفكار لاهوتية صعبة تطلبا من الكاتب الاستعانة بالعديد من المراجع والمصادر والحوليات التي أمدته بالكثير مما أراد معرفته، سواء بشكل مستقل، أو أثناء كتابة الرواية، وربما جاءت الكتابة تعبيرا عن هذه الإرادة وتلك الرغبة.
وأدى هذا إلى احتشاد الرواية بالعديد من المعارف التي تم اقتطافها واقتباسها، وتذويبها في مجرى السرد.
وقد أعطى هذا الرواية مسارًا معرفيًا أكثر من المسار التاريخي الذي توسلت به العديد من الروايات التي تناولت تاريخ بعض أتباع الأديان. فنحن هنا أمام رواية تطرح المعرفة التاريخية للمسيحية، وليس تاريخ المسيحيين، ولو كان الكاتب يريد الثانية ما لجأ إلى اختراع دير من مخيلته لتدور فيه أغلب الأحداث، والتقط واحدا من الأديرة المسيحية القديمة، واتخذ منه مكانا للرواية، وما لجأ إلى الفانتازيا في بعض جوانب روايته، وكأنه يريد أن يذكرنا طيلة الوقت، ليس من خلال الوصف والسرد والحوار فقط، بل من خلال التخيل أيضا، إلى أننا أمام عمل فني عميق ومهم ونتاج جهد فائق، حتى لو جاء حافلا ومكتنزا بالمعرفة أو محتفيا بها.
إعلان