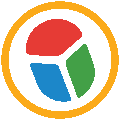- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
مثلما كشف ضابط الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق "جون بيركينز" John Perkins، عن دور المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والأمريكية في توريط شعوب ودول العالم النامي في فخ الديون Debits Trap، من أجل السيطرة على سياساتها وقراراتها السياسية والاستراتيجية، فإن التجربة التاريخية لكثير من الدول والإمبراطوريات القديمة التي انهارت وتفتتت، تكشف عن تأثير الديون الأجنبية في هذا المصير المؤلم، حدث هذا في مصر في عهد الخديوي إسماعيل، وانتهت باحتلال مصر عسكريًا من جانب بريطانيا، كما حدث في حالة الإمبراطورية العثمانية، وانتهت بانهيارها.
وتكشف الوثائق التاريخية لانهيار وسقوط الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إلى الدور الخطير والضار الذي لعبته الديون الأجنبية والداخلية، واستسهال الاقتراض من الخارج والداخل، والتآكل التدريجي لقوى الإنتاج.
تأثير الديون الأجنبية في انهيار الإمبراطورية العثمانية واحتلال مصر
بالإضافة إلى العوامل والعناصر التي نحرت كالسوس في قلب وعقل وأطراف هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف، من قبيل بروز النزعات القومية والإثنية، والصراعات المذهبية والدينية، ونمط الاستبداد السياسي، وغياب الأفق لإصلاح حقيقي يحترم رغبات الشعوب المكونة للإمبراطورية العثمانية، فقد أضيف إلى ذلك تنامي الديون الأجنبية، فيما يشبه، إلى حد التطابق، ما جرى في مصر في عهود أبناء محمد علي باشا الأربعة (سعيد – عباس – إسماعيل – توفيق)، وانتهى بها إلى الهيمنة الأنجلو – فرنسية على الشئون المالية والاقتصادية المصرية، ثم إلى الاحتلال البريطاني العسكري لمصر في يوليو عام 1882.
فالدولة العثمانية التي لم تعرف نظام وضع الموازنة المالية، بالمعنى المعروف سوى عام 1863، وبصورة أقل كثيرًا من المقاييس الحديثة التي بدأت عام 1910، نزلت إلى سوق الاقتراض لأول مرة إبان حرب القرم الشهيرة عام 1854، بقرض قيمته 3.3 مليون جنيه عثماني (ما يعادل 3.815 مليون جنيه إسترليني وقتئذ)، ثم استمرت في الاقتراض في السنوات اللاحقة حتى بلغت ديونها الأجنبية عام 1860 حوالي 16.54 مليون جنيه عثماني، وفى أواخر عهد السلطان عبدالمجيد كان الدين الأجنبي قد تجاوز 25.0 مليون جنيه عثماني، ثم قفز هذا الدين الأجنبي حتى بلغ عام 1871 حوالي 142.5 مليون جنيه عثماني، بينما لم يزد ما حصلت عليه فعليًا سوى 76.92 مليون جنيه عثماني، وبحلول عام 1873 كان الدين الأجنبي قد تجاوز 250.0 مليون جنيه عثماني (أى ما يعادل 290.0 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقم ضخم جدًا في ذلك الوقت، وتصدَّرت إنجلترا وفرنسا قائمة الدائنين للدولة العثمانية.
والحقيقة أن من بين هذا المبلغ لم يصل إلى الخزانة العثمانية سوى 127.57 مليون جنيه عثماني، أي ما يعادل النصف تقريبًا، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة التي بلغت في بعض السنوات 10% و12%.
ويبدو واضحًا كيف زاد متوسط سعر الفائدة من 7.6% خلال الفترة الأولى (1854-1960) إلى 9.55% فى الفترة اللاحقة (1862-1871)، وهو ما يذكرنا مباشرة بما توصل إليه ونقله لنا ضابط الاستخبارات الأمريكية الاقتصادى "جون بيركينز"، في كتابه الذي صدر عام 2003، وأحدث ضجة كبرى كما أشرنا من قبل، بما يؤكد على حقيقة واحدة ثابتة ومستمرة، وهي سياسات القوى الاستعمارية قديمًا وحديثًا في استخدام القروض والديون كمصيدة للدول المستهدفة.
وهكذا، وبحلول عام 1874 كان أكثر من نصف النفقات العامة الواردة في الميزانية للدولة العثمانية مخصصًا لخدمة الديون الأجنبية، وهي حالة سوف نجدها تتكرر في الحالة المصرية بعد قليل.
وقد استخدم الجزء الأعظم من هذه القروض بهدف تسديد أصول وفوائد الدين نفسه، كما ذهب جزء كبير من هذه الديون لصالح الإنفاق على الجيش والتسلح وأعباء الحملات العسكرية ضد المتمردين، ولم يتبقَّ سوى 45.0 مليون جنيه عثماني للأغراض الأخرى، تمامًا كما يجري في مصر في الوقت الراهن.
ولم يكن أمام الدولة العثمانية في ظل ضعف قدرتها الإنتاجية والتصديرية، وتفاقم العجز في ميزانها التجاري، سوى وسيلة واحدة، هي تحميل رعاياها بمزيد من الضرائب، فزادت ضريبة العشر ثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة، وكذلك الرسوم والعوائد الجمركية، وضريبة الحيوانات بمقدار الضعفين، مع عجزها عن تخفيض حجم المزايا والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للأجانب. تمامًا كما يحدث في الحالة المصرية الراهنة من تحميل الفقراء والطبقات الوسطى عبء الأزمة الاقتصادية، مع التوسع في منح المزايا الضريبية والجمركية والإعفاءات لرجال المال والأعمال، ومن يطلق عليهم في الخطاب الرسمي "المستثمرون".
ولم تفلح محاولات جدولة ديون الدولة العثمانية فى إنقاذها من المأزق، فما إن حل شهر أغسطس من عام 1876، إلا وكانت الدولة قد أعلنت عجزها عن سداد أقساط ديونها للدائنين، وأوشكت فعلاً على الإفلاس، خاصة أنها استمرت في إصدار سندات نقدية لديون داخلية تتزايد عامًا بعد آخر، فانخفضت النفقات على الخدمات الأساسية، فاندلعت التمردات في أنحاء الإمبراطورية العجوز، ما أودى بها في النهاية إلى التفكك والانهيار.
والمدهش والمثير للسخرية، أن هذه الفترة التي استغرقت الدولة العثمانية وسلاطينها في الاقتراض والاستدانة المفرطة، هي نفس الفترة التي أطلق عليها "الإصلاح" في تاريخ هذه الإمبراطورية المريضة، والتوسع في التجنيد وتسليح الجيوش، بما يقاربنا بصورة مأساوية من المرحلة الراهنة في التاريخ الاقتصادي والسياسي المصري، بزعم إجراء عملية إصلاح كبرى في البلاد، حتى تصل مصر إلى "أم الدنيا.. وقد الدنيا"..!
ويزيد الأمر تشابهًا، أن هذه الفترة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية العجوز قد شهدت التوسع في إنشاء المدارس الفئوية، وللطوائف المختلفة بعشرات ومئات المدارس، مثل مدارس الأرمن ومدارس اليهود وغيرها من الفئات والطوائف المحمية برعاية أجنبية، فتنامى نفوذ القوى العالمية والاستعمارية، أو ما يسمى الاستعمار الثقافي، تمامًا كما نشاهد اليوم في مصر من التوسع في افتتاح المدارس والجامعات الأجنبية (الأمريكية – الكندية – الألمانية – الفرنسية – اليابانية - البريطانية.. وغيرها).
وإذا تأملنا ما يجري في مصر منذ سنوات طويلة، نجد حالة من التشابه، تصل -للأسف- إلى حد التطابق، فالدين الأجنبي والدين المحلي أو الداخلي في مصر يتزايد عامًا بعد آخر، حتى أصبح عبئًا يفوق القدرة على خدمته، بالقدر الذي يمتص جزءًا كبيرًا من الموارد المتاحة سنويًا في الموازنة العامة للدولة لسداد الأقساط والفوائد بما يزيد على 50% على الأقل، ولم يبقَ للخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة سوى النذر اليسير.
فلنتأمل معًا الفوائد على القروض المحلية والأجنبية، فقد تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة (2014/2013 - 2018/2017) بصورة خطيرة ومثيرة للقلق، حيث زادت من 173.2 مليار جنيه عام 2014/2013 إلى 381.0 مليار جنيه عام 2018/2017، وإذا أضفنا إليها مخصصات سداد الأقساط التي زادت بدورها من 107.5 مليار جنيه عام 2014/2013 إلى 265.4 مليار جنيه عام 2018/2017، فإن الرقم يصل إلى 646.4 مليار جنيه في عام 2018/2017، مما أصبح يمثل عبئًا ثقيلاً فوق قدرة وطاقة الاقتصاد المصري على تحمله.
لقد بلغ مجموع ما سددته الدولة المصرية خلال خمس سنوات فحسب، من عام 2014/2013 حتى عام 2018/2017 حوالي 2.4 تريليون جنيه خدمة للديون الضخمة التي أغرقتنا فيها هذه الإدارة، وهذا العبء الضخم يكشف عن خلل جوهري في السياسات المالية للحكومة والنظام.
أما الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم (الباب الخامس)، فهو أحد المصادر الأساسية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وأحد المصائب الكبرى لحاضر ومستقبل هذه البلاد، حيث تمثل ديونًا هائلة على الاقتصاد والدولة والمجتمع المصري كله.
لقد زاد هذا الباب عامًا بعد آخر، حيث زاد من 363.3 مليار جنيه عام 2014/2013 إلى أن بلغ 635.6 مليار جنيه عام 2018/2017، ويردد بعض المسئولين في وزارة المالية مقولة خاطئة، وهي أن سداد القروض المحلية أو الأجنبية لا يشكل عبئًا حقيقيًا على الموازنة العامة للدولة، لأنه لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية، لكنه في حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة (ص 8 من البيان التحليلي لمشروع موازنة عام 2018/2017). والحقيقة أن هذا القول المغلوط مردود عليه من زاويتين، هما:
الأولى: أن تسديد جانب من القروض المحلية أو الأجنبية يؤدي – للأسف – إلى نزول الدولة مرة أخرى إلى سوق الاقتراض المحلية أو الأجنبية في صورة سندات وأذون خزانة من أجل سد استحقاقات أقساط الدين الداخلي أو الخارجي.
الثانية: أن هذه العقلية المالية البيروقراطية، تنظر إلى القروض والاقتراض وكأنها أمر اعتيادي، ينبغي التعامل معه باستمرار، وليس بوصفه عبئا سياسيًا واقتصاديًا على الدولة والمجتمع المصري، وأن من شأن الاستمرار فيه الوقوع في مصيدة الديون، وبالتالي تكريس التبعية وربما الاحتلال الحقيقي للدولة.
والخلاصة والنتائج التي نستخلصها:
أن السياسات المالية التي تسير عليها الإدارة الحالية، لا تختلف عمن تولوا قبلها، وزاد عليها التوغل بصورة غير مسبوقة في الديون الداخلية والخارجية من ناحية، والتوسع في مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية في الوقت الراهن، وفي الأجل المتوسط مثل العاصمة الإدارية التي هي أقرب إلى النشاط المضارب على الأراضي والعقارات لصالح السماسرة والمستثمرين في هذا القطاع، بعيدًا عن المشروعات التنموية.
كما أن استسهال الاقتراض والحصول على منح، قد وضع فعليًا السياسة المصرية داخليًا وخارجيًا، رهنًا للمطالب والضغوط من الخارج، فأفقد مصر الفرصة التاريخية التي لاحت في الأفق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مما يجعلنا نؤكد أن مسار السياسات المصرية لن يبتعد كثيرًا عن السياسات التي اتبعها طوال خمسين عامًا سابقة كل من الرئيسين أنور السادات (1971-1981)، وحسني مبارك (1981-2011).
فهل مصر بلد فقير حقًا؟ أو أن السياسات الراهنة ليست كفئًا؟
إعلان