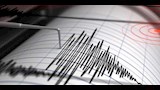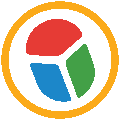قصة جزيرة يونانية يفر إليها اللاجئون من سوريا والعراق
لندن (بي بي سي)
جزيرة ليسبوس اليونانية تعد مقصدا سياحيا يجذب الكثير من الزوار ممن ينشدون الهدوء والاسترخاء، لكنها أصبحت مؤخرا مقصدا لآلاف اللاجئين الفارين من الحروب في سوريا والعراق، وغيرهما.
لعقد كامل ظلت جزيرة ليسبوس اليونانية مكانا أقصده دون عداه طلبا للراحة، فمهنتي ككاتبة رحلات وسفر تحتم علي العمل أثناء زيارتي للبقاع الخلابة حيث يتعين علي الالتزام بنظام يومي صارم، فضلا عن تدوين الملاحظات.
لكن في تلك الجزيرة التي تقع قبالة الساحل التركي اكتفي بتناول أسماك السردين المشوية، ومشاهدة أشعة الشمس المترقرقة على صفحة مياه بحر إيجة الزرقاء، وكنت أقنع بقضاء اليوم تلو الآخر بين السباحة، وقراءة الكتب، إذ لم أعتبر هذا المكان مكاني، بل مكان يخص زوجي صاحب الأصول اليونانية.
فزوجي "بيتر" يزور هو وأسرته الأمريكية اليونانية ليسبوس منذ عام 1992، ورغم عدم وجود صلات تربطهم بشكل مباشر بها، إلا أنهم شعروا بالارتياح الكامل فيها، وبالأخص بقرية سكالا إريسوس الصغيرة على البحر.
فقد أحبوا تلك البقعة بشوارعها الحجرية الضيقة والممشى الممتد بواجهة البحر بمقاهيه البسيطة والطبيعة الصخرية والمرفأ الواسع الهادئ.
وبانضمامي إلى تلك الرحلة السنوية، كانت أسرة زوجي قد أرست نمطا اعتياديا لزيارتها باختيارها لنفس الفندق، وهو فندق غاليني، ونفس المطعم، مطعم بانايوتا أو كوستا، فضلا عن مشاهدة الأفلام في السينما المفتوحة.
وكان مما ساعدهم أنهم جميعا يتحدثون اليونانية، أما أنا فكنت أومئ برأسي فحسب، دون أن أعي ما يدور من حديث، وحتى يوم زفافي أنا وبيتر في كنيسة القرية، كنت اكتفي بتحريك رأسي أيضا.
وعلى الخارطة التي زينت كافة مناضد المطعم، أخذت أتابع شكل الجزيرة المثلث، كنت أعرف أين تقع ميتيليني على الجانب الشرقي، إذ أميزها بمطارها ومرفأ العبارات، كذلك عهدت قريتنا ناحية الغرب، أما باقي أنحاء الجزيرة التي تناهز مساحتها 1600 كيلومتر مربع، فكانت بالنسبة لي عالما يلفه الغموض.
وفي عام 2015، توجهت أنا وبيتر لقضاء رحلتنا الصيفية في اليونان حين بدأ اللاجئون الفارون من الحرب في سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها يصلون شواطئ ليسبوس بأعداد أثارت اهتمام إعلام العالم، حيث وصلت قواربهم المطاطية المكتظة إلى شواطئ بعيدة عن قريتنا لكنها لا تبعد أكثر من عشرة كيلومترات عن تركيا.
وبسبب معرفتي باللغة العربية وزيارتي لسوريا عدة مرات، فقد تطوعت للتوجه للمساعدة، وسمح لي زوجي بالذهاب بمفردي حتى لا يمثل وجوده عائقا فاستأجرت سيارة وانطلقت في طريقي، ووجدتني لأول مرة أقود سيارة في ليسبوس.
كان قد جرى نصب مخيمات مؤقتة على نحو عاجل ينتظر بها الوافدون لحين تلقي أوراق التسجيل من الشرطة، ولم تكن الأماكن التي أقيمت عليها تلك المخيمات مميزة على الخريطة، وكل ما أعرفه أنها كانت على الناحية الأخرى من الجزيرة قرب ميتيليني، وهو الطريق الذي بالكاد أعرف كيف أصل إليه.
وبعد أن أخطأت الطريق خمس مرات ببلدة كالوني أنزلت زجاج نافذتي أخيرا وناديت باليونانية "أين طريق ميتيليني؟" وما كنت أصدق أنني استطعت تكوين تلك الجملة باليونانية، فأشار أحدهم إلى مسافة خمسين مترا إلى اليسار.
وكان مخيم كارا تيبي الذي خصص حينها للسوريين والعراقيين دون غيرهم أشبه بساحة ضخمة لانتظار السيارات.
انضممت إلى مجموعة من المتطوعين اليونانيين الذين كانوا يطهون المعكرونة للغداء، ويقدمون مئات الأطباق، وساعد ما أعرفه من العربية في توجيه الحشود للانتظام، أما إعداد الطعام فتم دون الحاجة لكثير من الكلام، وكان البعض يتحدث الإنجليزية، وكان هناك ما يكفي من طعام.
وقرب المساء، أخذت أسرة أفغانية في سيارتي كان أفرادها قد وصلوا خطأ إلى مخيم كارا تيبي فنقلتهم إلى مخيم موريا القريب المخصص للوافدين من أفغانستان والبلدان الأخرى.
وما إن وصلت حتى شعرت بالرهبة، إذا شاهدت أن المخيم قائم بمنشأة عسكرية سابقة ذات أسوار عالية، يعلوها السلك الشائك. وكان ذاك المشهد أمرا لم أعهده في ليسبوس، وما كنت أريد أن يدور يوما بمخيلتي.
وبعد أشهر قليلة، زرت الجزيرة بمفردي مجددا، إذ ساعدت منذ الصيف على تشكيل شبكة من المتطوعين وساعدتني معرفتي بالمخيم وبالجزيرة في الإسهام في كتيب إرشادي للراغبين في الرحلة.
وكان الوضع قد أصبح أكثر قتامة وتعقيدا، ومن ثم أتيت لتدعيم تلك الشبكة من المتطوعين ولتحديث الكتيب، ومد يد العون للاجئين ما استطعت.
وعندما كانت العَبّارة التي نقلتني من أثينا تقترب من المرفأ، دار في ذهني أن ما أفعله حماقة، فمعرفتي بالمكان محدودة تكاد تقتصر على طريق واحد قدت سيارتي فيه بالجزيرة، وعملي بمخيم واحد ونظرة استطلعت بها مخيما آخر.
كما لم أعرف ما قد يصادفني هناك، وما إذا كنت سأقدر على المواجهة، ولم يكن من سبيل للتغلب على القلق الذي ساورني سوى مواصلة السير.
وخلال ذاك الأسبوع، قدت سيارتي المستأجرة بالجزيرة ذهابا وإيابا جمعت خلالها المعلومات، وقمت بمزيد من الاتصالات بالمخيمات، وبمواقع رسو الزوارق، ونقاط تقديم المساعدة للاجئين.
وفي الطريق تعجبت لتلك الجزيرة التي لم أعهدها، فليسبوس التي اعتدتها كان اللون البني يغلب عليها تحت أشعة الشمس الحارقة في أشهر الصيف.
أما ليسبوس الآن فتتحلى بالخضار بعد أمطار الخريف، كما رأيت خلجانا من المياه الزرقاء الصافية لم أكن قد صادفتها من قبل، كما مررت بساحات قرى أخرى ممهدة بالحجارة، وطالعت البحر المطل على تركيا في الجانب الآخر.
وفي كل مرة كنت أنزل من سيارتي في بقعة جديدة، كنت أقابل الناس بتحية الصباح أو المساء باليونانية "كاليميرا" أو "كاليسبيرا"، فدون زوجي بيتر لم يكن في جعبتي الكثير من العبارات اليونانية لترديدها.
وأحسن اليونانيون استقبالي مستجيبين لأسئلتي بشأن حاجة المخيمات، كما قصوا علي ما دفعهم للمجيء للمساعدة، فهم أيضا لم تخل أسرهم من لاجئين. فقبل بضعة أجيال، وخلال الحرب اليونانية التركية وما أعقبها من تبادل للسكان عام 1923، أجبر أكثر من مليون ونصف من المسيحيين والمسلمين على ترك ديارهم.
قبل ذلك كنت أرى ترحاب اليونانيين بالأغراب في مطعم على الشاطئ، ولكن في حالة الطوارئ تلك جاء هذا الترحاب في هيئة غوث للفارين من العنف والاضطهاد الديني والسياسي، وكان ترحابا أعمق وأبلغ أثرا، ترحابا قويا ممزوجا بإحسان، ومدفوعا بتاريخ الجزيرة، استلهمت منه القدرة يوما بعد يوم بما عاينته من جهود أهل ليسبوس أنفسهم.
وكان آخر مكان أزوره في رحلة العودة هو مخيم موريا الذي كان قد اكتظ بمن فيه، وغمرته الأوحال وأحاط به المزيد من السلك الشائك، وبات المشهد أشد قتامة من ذي قبل حين أوصلت الأسرة الأفغانية صيفا.
تجولت مدة ساعة أقدم الخرائط والمنشورات التي تحوي إرشادات، فضلا عن جوارب جديدة وقطع الحلوى، ولكن الطاقة التي شعرت بها من قبل فارقتني، وشعرت أن ما أقدمه أشبه بقطرة في بحر.
وخارج السيارة لوحت لي أسرة كردية تسألني عن كيفية الوصول للميناء. وقبل أشهر ما كنت أستطيع أن أجيبهم، أما الآن فقد صرت على دراية بمواعيد الحافلات، فأيقنت أن الحافلة الأخيرة قد فاتتهم، وعرضت توصيلهم.
وفي الميناء، ساعدتهم على شراء تذاكر العبارة، ولم أتركهم إلا وقد تأكدت من تناولهم وجبة دسمة. وبينما هموا بأول جزء من رحلتهم، علت وجوههم ابتسامة لأول مرة منذ ساعات، وساعدتني ضيافتهم ولو لوقت قليل على مشاطرتهم الشعور بالأمل مجددا.
ومنذ ذلك الحين، عدت مرتين إلى ليسبوس بمفردي، وزرت خلالهما كل ركن تقريبا بالجزيرة التي بدأت أصغر من ذي قبل.
وقد أميط اللثام عن الغموض الذي كان يلفها، وباتت مكانا أكثر ثراء تعكس مسمياته عالمين أحدهما لجزيرة وادعة مسترخية خلال رحلاتي الصيفية، والأخرى لجزيرة مفعمة بأزمة اللاجئين.
ولا تخلو بقاع من ليسبوس من مآس، منها قرية موليفوس حيث كان سكانها في استقبال الضحايا والمتضررين جراء غرق إحدى السفن، وكذلك موريا، تلك البقعة القاتمة.
لكن الجزيرة بالنسبة لي مبعث سعادة جديدة مرجعها وضوح الهدف والعمل المشترك، وكما كتب أحد سكان الجزيرة لمجموعة المتطوعين فإن "ليسبوس باتت الآن مدرسة عظيمة يتعلم منها البشر كافة"، وحقا فكل مكان زرته جسد درسا في العطاء والرحمة.
وتلك الرحلات التي قمت بها إلى ليسبوس بمفردي كانت مختلفة تماما عن تلك التي قمت بها برفقة زوجي، كانت تخصني بذاتي حتى أنه حينما حان موعد رحلتنا الأسرية المعتادة في الصيف الماضي شعرت بنوع من التوجس، فهل لي أن أعود لما اعتدته من الاستلقاء تحت أشعة الشمس وتناول أسماك السردين المشوية، ومشاهدة الأفلام بالسينما المفتوحة؟
عقلي يدرك أن إجازتي تدر دخلا على الجزيرة، وتساعد اقتصادها السياحي المتضرر جراء الأحداث، لكن مع توجهنا إلى مقصدنا المعتاد بالجزيرة كنت أشعر أنني كمتسللة بين عالمين مختلفين تجمعها جزيرة واحدة.
ولم تمض أيام قلائل خلال رحلتنا إلا وتسللت فعلا لاحتساء الشاي برفقة متطوعة أسترالية عاشت في سكالا إريسوس لسنوات، وتعجب أحد أفراد أسرتنا كيف أعرف أصدقاء غيرهم هناك.
ورأيت أن صديقتي الأسترالية ليست على عجل لمواكبة حالة الطوارئ التي فرضها وصول الوافدين كما اعتدت قبلا، فتحدثنا عن حاجات اللاجئين وآليات عمل المتطوعين وظروف المعيشة بالقرية. ورويدا رويدا، بدأت أشعر أن عالمي ليسبوس بدءا ينضويان تحت شمس واحدة.
كل من رأيتهم في ليسبوس تعين عليهم إعادة رسم خرائطهم الشخصية للموائمة بين حياتهم السابقة والوضع الراهن، ولتقرير كيفية المساعدة، وأوانها ومكانها.
وبالنسبة للأسرة الأفغانية والأسرة الكردية ومئات الآلاف غيرهم ممن مروا هنا، أو من المحتجزين بالجزيرة، فإن ليسبوس تركت بصمتها على خريطة حياتهم.
هذه الجزيرة لم تعد فحسب مكانا لزوجي، بل لي أنا أيضا، ولكل من وطأت أقدامهم أرضها.
فيديو قد يعجبك: