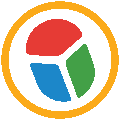- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
هناك عبارة لاتينية شهيرة تقول: «العقل السليم في الجسم السليم». إنها كلمات يتم تفسيرها غالباً للتدليل على أهمية الرياضة للجسم، وعلى أهمية الصحة الجسدية لبقاء العقل سليما.
لكن دعونا نتساءل: ماذا لو كان هناك إنسانٌ رجلا أو امرأة يتمتع بصحة جسدية رائعة، وبنية رياضية متينة، لكنه أناني، أو مصاب بخلل عقلي أو أي مرض آخر بالمخ، سواء كان وراثيا أو ناجما عن أزمة نفسية ألمّت به دون أن يجد له الأطباء دواءً؟
ماذا لو كان هذا الشخص صاحب الجسم الجميل يفتقد التكوين الثقافي والعلمي، الذي يجعله منتجاً مبدعاً أو مفيداً لوطنه؟
ماذا لو كان عقله غير منشغل إلا باللهو والعبث أو الاستمتاع بإيذاء الآخرين؟
هل يمكن هنا تطبيق مقولة «العقل السليم في الجسم السليم»؟!
على العكس مما سبق، قد يكون هناك شخص له عقل جميل، لكن جسده يعاني بعض الأمراض، أو أقعده حادث ما، لكن عقله لا يزال قادرا على تسيير حياته وتحقيق النجاح. صحيح أن العلاقة بين الجسم والعقل عَلاقةً تكامليّة تفاعليّة؛ فالجسم يتأثر بما يخوضه المخ وما يتعرض له من مؤثرات، مع ذلك، ورغم أي إعاقة فإن العقل يمكنه أن ينتقل بصاحبه - مهما تكن درجة العجز والمرض - إلى أرحب الآفاق، بالإرادة وبالقدرة على ممارسة التركيز لتحويل أحلك الظروف إلى فرص رائعة قد لا تتكرر في العمر.
إن أقوى وأبرز نموذج يدلل على رأيي السابق هو عالم الفيزياء البريطاني الشهير، ستيفن هوكينج الذي كان قد أصابه مرض خطير نادر، هو العصبون الحركي الذي كان يسبب له الشلل التدريجي، وتوقع له الأطباء وهو لا يزال في سن الثانية والعشرين ألا يعيش طويلاً، لكنه توفي وهو في سن السادسة والسبعين.
ليس هذا فحسب، فرغم اكتمال إصابته بالشلل الرباعي واصل حياته ودراساته الرائدة عن الكون والزمن، رغم فقدان القدرة على الحركة، ولم يكن يتمكن من الكلام إلا عبر جهاز تركيب أصوات. رغم ذلك وبفضل عقله وإرادته أصبح ستيفن هوكينج أحد أبرز علماء الفيزياء، وذاع صيته عندما نشر كتابه «موجز لتاريخ الزمن» الذي بِيع منه ما يزيد على عشرة ملايين نسخة.
هوكينج ليس استثناءً؛ فالتاريخ والحاضر زاخر بآخرين من أمثاله، وما سبق ليس تقليلا من أهمية الصحة الجسدية، وليس دعوة للبحث، أيهما أسبق: البيضة أم الدجاجة؟ ولكنه محاولة لمناقشة أهمية ودور العقل الإبداعي الذي يقبع في قمة رأس الإنسان، ويُدير هذا الكيان المعجزة.
العقل والقيادة
كذلك إدارة أي بلد في العالم تكاد تُشبه العلاقة بين العقل والجسد. لو وُجد العقل القادر على التخطيط والإدارة ومحاربة الفساد سوف يأتي اليوم، ويصح جسد المجتمع مهما تكن الأمراض التي يعانيها. إن وجود القائد الصالح والنموذج القدوة لا شك سيكون المرشد في رحلة الصواب.
عندما تأتي قيادة فاسدة فإنها تُدرك تماماً أن نجاح مهمتها في ممارسة الفساد يعتمد في جزء أساسي منه على البحث عن التربة القابلة للفساد، التربة التي يسهل التعامل معها في أدنى درجات المجتمع، وتبدأ في غواية هؤلاء الموجودين في أدنى طبقات السلم الاجتماعي، وتوريطهم في الفساد حتى تضمن سُكوتهم، إلى أن يُصبح المجتمع محاصر بثقافة الفساد من الأعلى والأسفل، فيتغلغل إلى طبقات عديدة حتى يخلق شبكة كبيرة أشبه بالخلايا السرطانية.
القائد الصالح يُدرك ما سبق جيداً، مثلما يعرف ماهية القوانين الضرورية لبناء المجتمع السليم، يُدرك أنه يحتاج إلى نماذج في أعلى الهرم يقتدي بها الناس، وبالتوازي يحاول الضرب على أيدي الفاسدين هنا وهناك وما بينهما.
هذا يتضح بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومَنْ يتأمل - بحياد ونزاهة وصدق - أوضاع مصر في بداية استلامه للحكم، وما يحدث الآن في أرض الكنانة سيشعر بالفارق الكبير. صحيح أن مشوار البناء والإصلاح لا يزال طويلاً، ولا يزال يحتاج جهوداً عديدة، لكني شخصياً وعلى مستوى قضايا المرأة وإشكاليات التفسير الديني أرى بوضوح الفارق الكبير بين السابق والحاضر، على الأخص في التفسير الديني الحديث، وفي الفتاوى التي يقدمها رجال الدين التي أصبحت تُساير ظروف العصر، وتبتعد عن التشدد والتعصب، والأهم من ذلك أنها تفسيرات تنأى بعيدا عن تحفيز أي طرف ضد الآخر، تفسيرات تتمتع بالبصيرة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. هنا لا يمكن إغفال أن ذلك الاعتدال والوسطية تم بتوجيهات القيادة الرشيدة.
«الجدعان» رؤية وفرصة
علي جانب آخر، يكفي أن نقارن بين ما كان يحدث قبل سنوات قليلة مضت وبين ما يحدث الآن، بين رغبتين متضاربتين، بين حلم الهجرة وحلم العودة، بين الرغبة في الهجرة التي كانت تسيطر على أي شاب أو فتاة لشعورهم بعدم الأمان وعدم جدوى العمل في هذا البلد على مدار سنوات. هنا لا أتحدث فقط عن الهجرة غير الشرعية وضحاياها، ولكن أيضاً عن شباب سلكوا الطريق الشرعي، وآخرين قرروا الإفلات بأموالهم لتكوين حياة جديدة في دول أوروبا وأمريكا.
أما الآن، فحلم العودة بدأ يُخايل كثيرين، وليس صدفة أبداً أن نجد شباباً ورجالاً مصريين عادوا إلى وطنهم بعد سنوات من العمل بالخارج. عادوا ليس فقط بسبب الحنين، ولكن لأنهم لاحظوا حركة البناء، أدركوا أن بلدهم يُمكن أن يفتح لهم أبوابه وذراعيه، لذلك عادوا بكل ما يملكون ليستثمروا في بلدهم مصر، سواء في مجال الزراعة أو الثروة الحيوانية، أو الأمن الغذائي بشكل عام.
ومَنْ لديه أي تشكيك في ذلك فليُشاهد البرنامج الرائع «الجدعان» على قناة «القاهرة والناس» والذي يقدمه الإعلامي القدير محمد غانم الذي لا يكتفي بتسليط الضوء على تلك التجارب الناجحة الرائدة، ولكنه يحاول تذليل الصعاب والعقبات أمامهم بالتواصل مع المسئولين وأصحاب القرار، والأهم أنه أثناء ذلك يُقدم للمصريين جوانب لا يروها وربما لا يعرفون عنها شيئا في بلدهم، ينقل لهم تجارب آخرين بكافة تفاصيلها المثيرة والمفرحة، ونماذج يمكن لآلاف الشباب والشبات أن يقتدوا بها على طريق مستقبلهم وبناء مشروع حياتهم.
زراعة الأكوابونيك وحرب المياه
مؤخراً شاهدت حلقة من البرنامج عن زراعة «الأكوابونيك». كان بطلها الدكتور هشام حجاج، خبير الزراعة المائية، أستاذ العلوم والاقتصاد، وحرمه السيدة شادية باشا، اللذين ينتجان خضروات وأسماكا تأتي بأرباح تقدر بمائة ألف جنيه شهرياً في مزرعتهم بهرم سيتي ومساحتها ألف متر فقط.
كنت في حالة عدم تصديق من روعة وبراعة الفكرة. لم يكن الربح وحده هو المبهر والمُغوي في هذه الحكاية. لكني تذكرت الحرب المقامة من حول سد النهضة، والمخاوف من قطع مياه النيل، ساعتها لن يكون هناك قيمة ولا فائدة من وجود السد العالي، لن يولد الكهرباء، لن يجد مياهاً لتخزينها.
هنا دور القيادة الرشيدة، فليس صدفة أبدا مساعي الرئيس وجهوده المكثفة لتوفير طاقة بديلة، وذلك رغم مساعيه الدولية والإقليمية لحل مسألة السد بشكل سلمي تارة، ومن خلال الضغوط تارة أخرى. لكن اللافت أنه لم ينتظر التوصل للحل. فكر في احتمالات أخرى عديدة.
لكن لا تزال مشكلتنا مع سد النهضة لا تقتصر على الكهرباء فقط، هناك أيضاً الزراعة وأمننا الغذائي، إذ نعتمد على ٩٠٪ من مياه النيل. هناك مخاوف من التعرض للجفاف.
دور الحكومة في تشجيع الأكوابونيك
لذلك أرى فكرة ومشروع الدكتور هشام حجاج عبقرية لمواجهة إشكالية نقص المياه، وعلى الحكومة أن تعمل على تشجيعها وتطبيقها على أوسع نطاق بكافة أنحاء الجمهورية من الآن لعدة أسباب، أولها أن الزراعة المائية صديقة للبيئة، من دون مبيدات، بمعنى أن المشروع يجمع بين زراعة النباتات وتربية الأسماك في دورة مغلقة، عالم فريد من نوعه في الزراعة.
بدأت الفكرة من الثروة السمكية ومحاولة التخلص من مخلفاتها من الأمونيا بطريقة آمنة، فكان الاقتراح بوضع السمك بجوار النبات في بيئة واحدة، في دائرة مغلقة ليستفيد من مخلفات الأسماك.
من هنا، ظهر مصطلح الأكوابونيك، المدهش أن هذا الأسلوب في الزراعة يُقلل الفاقد من المياه بنسبة ٩٠٪. فعلى مدار خمس سنوات لم يتم تغيير المياه في أحواض الزراعة ولا مرة، وفق تصريح د. حجاج، كما أكد أنه لا يُضيف أي عناصر سماد خارجية، كذلك نتيجة وجود الأسماك في هذا النظام الزراعي، فإنه لا يستطيع رش أية مببيدات ضارة، لأن السمك سوف يتأثر بها فورا.
الجميل في الأمر أن المشروع ينتشر، فعند إذاعة الحلقة للمرة الأولى كان هناك نحو ٣٠٠ شاب من المريدين للدكتور هشام حجاج، الذين يقلدون مزرعته بالكامل، وعقب إذاعة حلقة البرنامج انهال عليه عدد كبير فأقام دورات تدريبية على مدار أسابيع قدم خلالها خلاصة خبرته وكل الدعم الفني بدءا من المعلومات والتدريب على الزراعة وحتى التسويق. مثلما قام بزراعة نحو ١٢٠ ألف شجرة توت للناس البسيطة من سكان هرم سيتي.
بقي أن أقول إنني شاهدت عدة برامج قام بها آخرون عن نفس الموضوع، لكنني لم أجد هذا الحماس والألق والجمال الذي شاهدته في برنامج «الجدعان»، إنه محصلة عمل فريق بأكمله يصنع البرنامج بقلبه، وبإيمان عميق وصدق، مذيع وإعلامي يفهم ويبحث، ويناقش ما يراه خارج حدود المنطق والعقل كأنه يضع نفسه في موقع المتفرج، ومدير تصوير ومخرج يهتم بالإيقاع والصورة، وحركة وزاوية الكاميرا وأحجامها لينقلنا إلى المكان فنرى أدق التفاصيل، بصحبة موسيقى دائما مشوقة تزيد من قوة الإيقاع. فتحية تقدير للجدعان.
إعلان