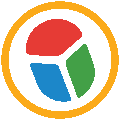مؤرخون في ندوة بمعرض الكتاب: الصحافة المصرية أفضل من رصد وأرخ ثورة 1919
معرض الكتاب
القاهرة- أ ش أ:
نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 ندوة، اليوم الاثنين، بعنوان "ثورة 1919 – بين الأدب والصحافة" بمشاركة كل من المؤرخ عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، والكاتب والباحث عبد الله الصاوي، وأدارتها الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.
وقالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، إن ثورة 1919 استطاعت أن تصهر في بوتقتها كافة التيارات الثقافية وطبقات المجتمع بمختلف الانتماءات؛ مما ساهم في تحولها لثورة شعبية حقيقية تحت شعار "الدين لله والوطن للجميع"، لافتة إلى أن الصحافة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بثورة 1919، وتعتبر الصحافة المصرية هي المرجع الرئيسي لأحداث الثورة.
وأضافت أن الصحف المصرية سجلت بكافة اتجاهاتها أحداث الثورة بما حوتها من اختلافات وانقسامات وأحداث، فلم تستطع أية جهة أخرى بخلاف الصحف تسجيل أحداث 1919 كما سجلتها الصحافة المصرية.
ونوهت عبدالرحمن، إلى أن عدد الصحف المصرية إبّان ثورة 1919 بلغ نحو 19 صحيفة، تمثل 60% منها ملكية كاملة للمصريين، و40% منها مملوكة للشوام.
وقال الدسوقي إن فكرة ثورة 1919 بدأت تتجلى في نفوس المصريين عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882 وبدأت تنشأ الحركة الوطنية في مصر على يد الزعيم مصطفى كامل، خاصة بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر في أعقاب إرهاصات الحرب العالمية الأولى، حتى بدأ الاحتلال الإنجليزي في طمس الهوية المصرية والتحكم في الحياة السياسية في مصر وإعلان الأحكام العرفية بالتزامن مع بداية الحرب العالمية الأولى.
وأضاف أن المؤشرات الأولى لتشكيل وفد مصري للسفر لباريس للمشاركة في مؤتمر فرساي للمطالبة بحق تقرير المصير بعد إعلان توقيع الهدنة بين الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى، كان على يد الأمير عمر طوسون من الأسرة المالكة الذي اجتمع مع الزعيم سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية المصرية بالانتخاب (إذ كانت الجمعية التشريعية في ذلك التوقيت لها وكيلين أحدهما بالتعيين والآخر بالانتخاب) وأقنعه بضرورة السفر لباريس للمطالبة بحق تقرير المصير.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد الأشخاص نصح الأمير عمر طوسون بالابتعاد وعدم السفر والظهور في الصورة، فلم يبقَ سوى سعد زغلول الذي توجه للمندوب السامي البريطاني ليطلب منه الموافقة على تشكيل وفد مصري برئاسته للسفر لباريس للمطالبة بحق تقرير المصير، وهو الأمر الذي رفضه المندوب البريطاني لسببين: أولهما عدم وجود حيثية لسعد زغلول، الذي كان قد قدم نفسه على أنه وكيل الجمعية التشريعية وهو ما رفضه المندوب البريطاني باعتباره لا يمثل الجماهير، ومن هنا بدأت تظهر لدى سعد زغلول فكرة جمع توكيلات شعبية من المواطنين للسماح له للسفر بوفد مصري إلى باريس، إلا أن المندوب السامي البريطاني لم يوافق على الأسماء التي جاءت في الوفد الذي شكله سعد زغلول.
وأوضح الدسوقي أن المندوب السامي البريطاني شعر بخطورة سعد زغلول؛ فتم نفيه إلى جزيرة مالطة وهو ما أدى إلى خروج المصريين للمطالبة بعودة سعد زغلول، وهنا لجأ الاحتلال البريطاني لإشعال الفتنة الطائفية بين المصريين والأقباط في محاولة منهم للتلاعب بمشاعر المصريين لوأد الثورة والاحتجاجات المصرية، إلا أن المصريين نجحوا في تجاوز هذه العقبة وأفشلوا مخططات الإنجليز لإشعال الفتنة الطائفية،وهو ما تجلى بوضوح في خروج الشعب المصري بكل فئاته في ثورة 1919 والمطالبة بالإفراج عن سعد زغلول.
ونوه عبد الله الصاوي، وهو مؤسس مشروع "ذاكرة الكاريكاتير"، إلى أن الحضارة المصرية القديمة كان لها السبق في تقديم فن الكاريكاتير للعالم، من خلال العديد من الرسوم التي تمتلئ بها متاحف العالم.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعصر الحديث فقد ارتبطت الصحافة المصرية ارتباطاً وثيقاً بثورة 1919 وما صاحبها من إرهاصات وأحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، كما كانت الصحافة أحد أهم الآليات التي مهدت الطريق للثورة، إذ أخذت على عاتقها منذ نشأتها مسئولية تنوير الأذهان ومحاربة الاستبداد، وعمدت إلى نشر أفكار وآراء رواد الفكر المصري المستنير.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالكاريكاتير ارتبط الحديث عنه في مصر ارتباطاً وثيقاً بصحافة يعقوب صنوع ورسوماتها؛ إذ يُعَد يعقوب صنوع أول من أسس الكاريكاتير الحديث في مجلاته العديدة التي أصدرها وأولها مجلة "أبو نظارة" عام 1877، وهي أول صحيفة هزلية كاريكاتيرية في الشرق، تكتمل فيها مقومات الصحافة المصرية "أكثر من غيرها وأقرب "، مشيراً إلى أن صنوع وضع الأساس الأول للكاريكاتير المصري.
وأوضح أنه بدخول مصر عتبات القرن العشرين تحول الكاريكاتير إلى أداة للانتقاد السياسي والاجتماعي، بل تحول كذلك إلى أداة سياسية خاصة حينما بدأت الحياة الحزبية في عام 1907، وهو ما جعل الأحزاب تصدر مجلات، أو تساعد بعض الصحفيين لإصدار مجلات كاريكاتيرية، وهكذا حدث نوع من الحراك السياسي والاجتماعي، وظهرت سلالة جديدة من رسامي هذا الفن لتخوض معارك ضارية ضد الفساد والمفسدين، أو على الأقل تحمل وجهة نظر الصحف أو الأحزاب التي تعمل من خلالها، وتدافع عن أفكارها.
وأشار إلى أنه بعد تشكيل الوفد المصري،انقسمت الصحف الهزلية ما بين مؤيدة ومعارضة؛وهكذا برزت صحافة النقد السياسي الساخرة، فكانت أبعد أثراً وأكثر رواجاً من الصحافة الأدبية،وبدأ بالتالي الرسم الساخر يحتل مكانه في صحافة النقد السياسي ويزدهر شيئاً فشيئاً،خاصة مع نشاط الحياة السياسية كأسلوب استخدمته الصحافة الساخرة ضمن وسائل الكفاح التي اتبعتها خلال ثورة 1919 ضد الحماية والمطالبة بالاستقلال والدستور ثم كوسيلة للصراع الحزبي بعد ذلك.
ونوه الصاوي إلى أنه من أدق ما كُتِبَ عن العلاقة بين الكاريكاتير وثورة 1919، ما ذكره الأديب والكاتب الراحل يحيى حقي في كتابه "تعال معي إلى الكونسير مع الكاريكاتير في موسيقى سيد درويش": "كان من الطبيعي أن يكون الميدان السياسي هو الذي استدعى وقبل بترحاب لعلعة الفن الكاريكاتوري وخاصة بعد نشوب الخلاف بين سعد وعدلي وبدء قيام أحزاب متنافرة. وضعت الثورة وراء ظهرها وسعت لمفاوضة الإنجليز، أي حينما أصيبت ثورة سنة 1919 بالإجهاض، فقد اندلع الكاريكاتور ليكون سلاح معركة التطاحن بين الأحزاب، ولكني أعتقد أنه كان يوفر للشعب وسيلة للتعويض عما يحس به من مرارة وألم لإجهاض ثورة سنة 1919، فالكاريكاتور في تلك الحقبة كان طعنا وتنفيسا في آن واحد".
وقال إنه بعد أن نهض فن الكاريكاتير في مصر على يد فنانين أجانب منهم الإسباني جوان سِنتيس، والشركسي علي رفقي، والأرمني المصري ألكسندر صاروخان، حمل الراية فنانين مصريين كبار أبرزهم: محمد عبد المنعم رخا، وزهدي العدوي، وأحمد طوغان، وعبد السميع عبدالله، وصلاح جاهين، وبهجت عثمان، وحجازي، وجورج البهجوري، وإيهاب شاكر، ومحيي الدين اللباد، وجمعة فرحات، ومصطفى حسين الذي شكل مع الكاتب الساخر أحمد رجب ثنائياً مبدعاً أنتج شخصيات كاريكاتيرية دالة ولامعة، مثلت مختلف شرائح المجتمع المصري، وانتقدت أداء الحكومات المتعاقبة، وتحولت في أذهان القراء إلى شخصيات من لحم ودم، وهذا غاية ما يصل إليه الفنان من نجاح.
هذا المحتوى من

فيديو قد يعجبك: