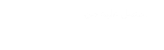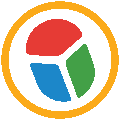حدود الحرب العالمية الأولى.. ميراث الشرق الأوسط الثقيل
حدود الحرب العالمية الأولى.. ميراث الشرق الأوسط ال
أظهرت إحدى الخرائط، التي تحمل علامات بقلم رصاص ترجع إلى العقد الثاني من القرن العشرين، أظهرت طموح – وحماقة - خطة لبريطانيا وفرنسا عمرها 100 عام، ساهمت في تشكيل الشرق الأوسط الجديد.
وبما أن الخطوط المستقيمة على الخريطة ينتج عنها حدود غير معقدة، لذا قد يكون ذلك هو السبب وراء الخطوط التي اتفق عليها كل من مارك سايكس، ممثلا عن الحكومة البريطانية، وفرانسوا جورج بيكو، ممثلا عن الحكومة الفرنسية، في اتفاقهما المبرم عام 1916، الشهير في العالم العربي باسم اتفاق سايكس- بيكو.
وكان سايكس وبيكو داهيتين، تربيا على الحياة الأرستقراطية وعاشا فترة إدارة المستعمرات، وكانا من أشد المؤمنين بأن شعوب المنطقة ستكون أحسن حالا تحت حكم الإمبراطوريات الأوروبية، وكانا كذلك على معرفة وثيقة بأحوال الشرق الأوسط.
ولا تزال مبادئ الاتفاق الرئيسية، التي تفاوض بشأنها الاثنان نسبيا على عجل وسط اضطرابات الحرب العالمية الأولى، تؤثر في المنطقة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من أن تلك الخطوط المستقيمة أثبتت نجاحها الكبير في مساعدة بريطانيا وفرنسا في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن تأثيرها على سكان المنطقة كان مختلفًا بعض الشيء.
وقسمت الخريطة التي رسمها الرجلان منطقة نفوذ الحكم العثماني منذ بدايات القرن السادس عشر إلى دول جديدة، ثم وضعت تلك الكيانات السياسية تحت نطاقين من النفوذ: أحدهما تحت سيطرة النفوذ البريطاني متمثلا في العراق وشرق الأردن وفلسطين، والآخر تحت سيطرة النفوذ الفرنسي متمثلا في سوريا ولبنان.
ولم يكن سايكس وبيكو مكلفَيْن بإعادة رسم حدود الدول العربية في شمال إفريقيا، لكن تقسيم النفوذ هناك كان موجودا أيضا، فأصبحت مصر تحت السيطرة البريطانية، فيما سيطرت فرنسا على المغرب.
غير أن هذا الفرز الجيوسياسي الذي تمخضت عنه تلك الاتفاقية به ثلاث مشكلات.
الأولى، أن الاتفاق جرى إبرامه سرا دون معرفة العرب، ناسفا وعد بريطانيا الرئيسي الذي قطعته على نفسها في العقد الأول من القرن الماضي، بأنه في حال ثار العرب ضد الحكم العثماني، سينالون استقلالهم عقب سقوطه.
وعندما لم يتحقق هذا الاستقلال، الذي وعدت به بريطانيا، بعد الحرب العالمية الأولى، وطغت نفوذ القوى الاستعمارية في العشرينيات والثلاثينيات وحتى الأربعينيات على العالم العربي، تحولت قوة السياسية العربية في شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط تدريجيا من بناء أنظمة دستورية ليبرالية (كما جرى في مصر وسوريا والعراق في بداية القرن العشرين) إلى قومية حاسمة، وركزت أهدافها في الأساس على التخلص من الاستعماريين والأنظمة التي تعاونت معهم.
وكان ذلك هو السبب الرئيسي في ظهور أنظمة عسكرية بسطت سيطرتها على كثير من الدول العربية منذ عام 1950 حتى انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وتكمن المشكلة الثانية في النزعة الشديدة إلى رسم خطوط مستقيمة. حيث كانت اتفاقية سايكس-بيكو تهدف إلى تقسيم المشرق العربي على أساس طائفي.
فلبنان أصبح ملاذا للمسيحيين (المارونيين خاصة) والدروز، فيما أصبحت فلسطين مقصدا لطائفة كبيرة من اليهود. وكان وادي البقاع، الواقع بين الدولتين، من نصيب المسلمين الشيعة، بينما حددت سوريا للمسلمين السنة، أكبر طوائف المنطقة جغرافيا.
وفي الفترة منذ نهاية الحروب الصليبية وحتى وصول القوات الأوروبية في القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من ازدهار ثقافة التجارة بالمنطقة، عاشت تلك الطوائف المختلفة حياة منفصلة عن بعضها البعض.
إلا أن ما كان اتفاق سايكس- بيكو يرمي إليه لم يتحقق، وهو ما يعني أن الحدود الجديدة التي جرى تحديدها لم تنسجم مع التمييز الطائفي والقبلي والعرقي على الأرض.
كما نحى العرب تلك الاختلافات جانبا، تارة تحت لواء النضال العربي لطرد القوى الأوروبية، وتارة أخرى تحت موجة القومية العربية.
وفي الفترة بين أواخر الخمسينات وأواخر السبعينات من القرن الماضي، وخاصة أثناء صعود نجم الرئيس المصري جمال عبد الناصر بين أزمة السويس عام 1956 وحتى نهاية الستينيات، أعطت القومية العربية زخما شديدا لفكرةٍ مؤداها أن العالم العربي يستطيع إذا ما اتحد أن يعمل على تقليص الفوارق المجتمعية الديموغرافية بين شعوبه.
وفي ثمانينات ذلك القرن وتسعيناته، استطاع رجال الدول العربية الأقوياء أمثال حافظ الأسد وصدام حسين في المشرق العربي والعقيد معمر القذافي في شمال إفريقيا إذابة الفوارق غالبا عن طريق استخدام العنف المفرط.
غير أن التوترات والطموحات التي خلقتها تلك الفوارق لم تختف أو حتى تخفُت. فعندما بدأ بعض التصدعات تطرأ على تلك الدول، أولا بسبب الاختفاء التدريجي لرجالها الأقوياء وثانيا بسبب تحول بعض الجمهوريات العربية تدريجيا إلى إقطاعيات تسيطر عليها مجموعات صغيرة من أصحاب المصالح الاقتصادية، ومؤخرا بسبب اندلاع انتفاضات عام 2011، طفت على السطح من جديد الإحباطات والخلافات والآمال التي ظلت مغمورة لعقود طويلة.
وتتمثل المشكلة الثالثة في أن نظام الدولة الذي جرى بناؤه في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد أظهر جليا فشل العرب في التعامل مع إشكالية ظلت تواجههم طيلة قرن ونصف القرن، وهي إشكالية الصراع على الهوية بين القومية والعلمانية من ناحية وبين الإسلامية (وأحيانا المسيحية) من ناحية آخرى.
وشهد العصر الليبرالي العربي الذي امتد من أواخر القرن التاسع عشر إلى أربعينات القرن العشرين إنشاء مؤسسات ديمقراطية مثل الدستور العلماني في تونس عام 1861، وتدشين حقبة الديمقراطية الليبرالية في مصر في فترة ما بين الحربين. وقام رواد هذا العصر بطرح خطاب رحبت به مختلف الفئات المجتمعية لاسيما المنتمين إلى الطبقة الوسطى، إلا أنهم فشلوا في تأطير المرجعيات الدينية لمجتمعاتهم المتدينة المحافظة ووضعها في سياق مشروعهم الحداثي الطموح.
وبالرغم من التقدم الملحوظ في التصنيع، فقد ظل التفاوت شديدا بين الشرائح العليا من الطبقات الوسطى والغالبية الكاسحة للشعوب. أما رجال القومية العربية الأقوياء فقد طرحوا خطابا مغايرا، اشتراكيا وأحيانا عسكريا، حظي بالمساندة الشعبية وإن كان على حساب الحريات المدنية والسياسية.
وعلى مدار أربعة عقود لم يكن للعالم العربي مشروع قومي أو محاولة جادة لمواجهة تناقضات نسيجه الاجتماعي.
كان هيكل الدولة معدا للانفجار، وكانت التغيرات الديموغرافية هي الزناد. فقد تضاعف تعداد سكان الوطن العربي خلال العقود الأربعة الماضية ليصل إلى 330 مليون نسمة يصنف الثلثان منهم تحت سن الخامسة والثلاثين.
وقد ورث هذا الجيل مشاكل اقتصادية اجتماعية سياسية حادة لم يكن مسؤولا عنها، وإن كان يرزح تحت وطأتها، بدءا من مستوى التعليم المتدني، إلى فرص العمل الشحيحة، وضآلة الفرص الاقتصادية، وصولا إلى انسداد الأفق في المستقبل.
وهكذا جاءت انتفاضات الشباب التي بدأت في عام 2011 كمحاولة لتغيير نظام الدولة الذي أسس بعد الحرب العالمية الأولى وأفضى إلى كل تلك الأوضاع.
وقد يجلب هذا التحول جيلا من الشباب الباحث عن مستقبل أفضل، كما قد يجلب موجات من الفوضى تجتاح المنطقة لسنوات قادمة.
فيديو قد يعجبك: