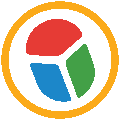تفسير الشيخ الشعراوي للعبرة من مقام إبراهيم
تفسير الشيخ الشعراوي للعبرة من مقام إبراهيم
قال تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.. [آل عمران : 97].
إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة في قوله الحق: {فِيهِ آيَاتٌ} و{بَيِّنَاتٌ} وهي وصف الجميع. وبعد ذلك قال الحق: {مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ} إنه سبحانه لم يذكر إلا مقام إبراهيم بعد الآيات، والمقام آية واحدة، وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات البينات، ونحن نقرأ {مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ} بفتح الميم الأولى في كلمة (مقام) ولا ننطقها (مقام) بضم الميم الأولى لأن المقام بضم الميم تعني مكان إقامة إبراهيم، أما مقام بفتح الميم فمكان القيام، لماذا كان قيام إبراهيم عليه السلام؟
لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام، وكان إبراهيم يقوم على (حجر). وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآيات البينات؛ لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه، وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى مطلوب الله- كما قلنا من قبل- لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وإتمام، فقال إبراهيم في نفسه: (ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداي؟) ولم تكن هناك في ذلك الزمن القديم فكرة (السقالات)، ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إسماعيل. وأحضر إبراهيم عليه السلام حجرا، ووقف عليه؛ ليرفع القواعد قدر الحجر.
إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر الاستطالة البدنية فقط، ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه الله، وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام: {وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمين} .. [البقرة: 124].
أي أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا، ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه أتى بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر. ونعرف أن الذي ساعده وشاركه في رفع القواعد هو ابنه إسماعيل. ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن الحجر يسع وقوف إنسان واحد، وهكذا نفهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده الأحجار، أما مكان الأقدام الموجودة في هذا الحجر، فهذا يعني أن إبراهيم عندما كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين في مكان آمن حتى لا يقع.
فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يحتال هذه الحيلة قال لخليله: سأكفيك مؤنة ذلك. وجعل الحق القدمين تغوصان في الحجر غوصا يسندهما حتى لا تقعا.
والذي لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألاَنَ لإبراهيم الحجر، نقول له: إن إبراهيم قد احتال، وخاف أن تزل قدمه، فنحت مكانا في الحجر على قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر، وهذه آيات بينات. فخذ ما يتسع ذهنك وفهمك له، إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبني القواعد ويرفعها أكثر مما تطول يداه، وقد مكّن الله له في ذلك وأعانه عليه، ونحن نعلم أن الهداية تكون هداية الدلالة وهداية المعونة. {والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ} .. [محمد: 17].
{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}، والآيات هي الأمور العجيبة، وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها. ودخول البيت يعني الأمن للإنسان الذي يدخله، ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه في هذا المكان. وهذا المكان تجتمع فيه القبائل، وبين بعض هذه القبائل ثارات ودماء وحروب، لذلك يبيّن الله الوضع الذي بمقتضاه تحقن الدماء {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} لماذا؟ لأنه بيت الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولو كان قد أجرم جرما يوجب الله عليه الحد فيه. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب- والده لم أتعرض له.
ولكن يُضَيّق الخناق على المجرم حتى يخرج. وهذا الأمن محدد بأي أمر اقترفه في دنياه، أما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شيء آخر، إنها درجة عالية من فضل الله، والآيات البينات الواضحة في البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام، وليحقق الله أمل كل راغب في زيارة البيت الحرام، وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد أن يعود للزيارة مرة أخرى. فساعة تدخل البيت الحرام فأنت هنا تتجه إلى مكان في البيت والمقابل لك في الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل، إلى أن تصير الاتجاهات مشتملة على الكعبة كلها. ونحن عندما نكون في الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى لأننا نراها، ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع بأنه منها، والحطيم، وهو القوس المبنى حول حجر إسماعيل، هو من الكعبة أيضا، ولكن النفقة قصرت، فجعلوه ليحدد مكان الكعبة، فظل هكذا، فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه يكفي أن يتجه إلى جهتها.
ولذلك نجد الصفوف في الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة؛ لأن الذين يصلون في داخل الحرم يشاهدونها، أما الذين يصلون خارجها فيكفي أن يتجهوا إلى جهتها ولو طال الصف إلى ألف متر، لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون معتدلا، أما في داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لأن أقضى بُعد في الكعبة هو اثنا عشر مترا وربع المتر، ونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر الأسود تجد الناس تتهافت على تقبيله، والحجر يمثل أدنى أجناس الكون، ونعلم جميعا أن الإنسان مستخلف كسيد في الكون، ومن بعده الحيوان أقل منه في الفكر ومسخر، ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات، ومن بعد ذلك يأتي جنس الجماد ومنه الحجر.
إننا نرى هذا الإنسان السيد في الكون لا يقبل الله منه النسك القبول التام الحسن إلا إذا قبل الحجر، أو حياه، وهكذا ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناها. والناس تزدحم حول الحجر، ومن لم يقبل الحجر يحس أنه افتقد شيئا كثيرا، وهكذا ترى استطراقا وسلوكا من الخلق إلى باب الله، فالإنسان المتكبر الذي يتوهم أنه سيد على غيره، يأتي إليه أمر في النسك بتقبيل الحجر أو تحيته بالسلام، وهذا الإنسان برغم أن الحق سبحانه يقبل منه أن يحيي الحجر الأسود بالسلام ولم يفرض عليه أن يقبّله ولكنه مع ذلك يحاول أن يقبل الحجر، وهو أدنى الأجناس، لأن الله قد عظمه، وهذا أول كسر لأنف غرور الإنسان، وحتى لا يظن ظان أنها حجرية أو وثنية، يأتي الأمر من الحق برجم حجر آخر.
إذن فالحجرية لا ملحظ لها هنا، فنحن نجد حجرا يُقدس، وحجرا آخر يُرجم. نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره. وذلك يدل على رضوخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقط، فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا فالمؤمن يؤدي حق التعظيم بالسمع والطاعة، وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر آخر، فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا، فالذاتية الحجرية لا دخل لها على الإطلاق. وبعض من أصحاب الظن السيء قالوا: إن الإسلام قد استبقى بعض الوثنية.
ولهؤلاء نقول: ولماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود، ولم تذكروا رجم إبليس وهو ثلاثة أحجار؟ لقد عظم المؤمن المؤدي للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار، إن المؤمن إنما يطيع أمر الله، فليست للحجر أي ذاتية في النسك أو العبادة. لقد رفعنا الحق من حضيض عبادة الأصنام التي هي عين الكفر، لكنه قال لنا: (قبلوا الحجر الأسود) فقد قبلنا الحجر احتراما لأمر الآمر، وذلك هو منتهى اليقين. لقد نقلنا الحق من مساو إلى مساو، من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله، لكن الأصنام كانت منتهى الشرك، وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين. أليست هذه آيات بينات؟
وزمزم التي توجد في حضن الكعبة، أليست آيات بينات؟ إن (هاجر) تترك الكعبة وتروح إلى (الصفا) وتصعد إلى (المروة) بعد أن تضع (إسماعيل) بجانب الكعبة، وتدور بحثا عن المياه. وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طيرا أو تجد إنسانا يعرف طريق المياه لان ابنها يحتاج إلى الشرب، ولو أنها وجدت على الصفا أو المروة مياها في أول سعيها أكانت تجد تصديقا لقولها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة في هذا المكان (إن الله لا يضيعنا) إنها سعت.
وكأن الله يقول لها ولكل إنسان: عليك بالسعي، ولكن لن أعطيك من السعي، إنما أعطيك الماء تحت رجل إسماعيل. إذن فصدقت في قولها: لن يضيعنا الله، لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط، ولا يمكن لامرأة في مثل عمرها أن تقدر على أكثر من ذلك، وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب، ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسبب الأسباب، وهو الله سبحانه، وفي هذا ما يعدل سلوك الناس جميعا. فساعة يرى الإنسان أن البئر مكان قدم إسماعيل وعلى البعد تكون الصفا والمروة، وتسعى بينهما، وبعد ذلك تجد زمزم مكان ضربة قدم إسماعيل، أليس في هذا آيات بينات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخذ بها، ويتعلق القلب بمسبب الأسباب؟
إن هذا يعطي المؤمن إيمانية التوكل، وهي تختلف عن الكسل و(بلادة التواكل) فإيمانية التوكل هي أن الجوارح تعمل، والقلوب تتوكل، أما الكسل عن الأخذ بالأسباب مع الادعاء بالتوكل فهذه بلادة، ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يأتي الأكل أمامه يأكل بنهم وشره، ولو كان صادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه، ولماذا يمضغها إذن؟ لماذا يختار التواكل والكسل، وعدم العمل، ثم يمد يده ليأكل؟ إن هذه هي (صفات التواكل).
إننا نأخذ من سعي (هاجر) وتفجر الماء عبرة، هي الأخذ بأسباب الله، وبعد ذلك فإننا نجد كل إنسان في البيت الحرام مشغولا بنفسه مع ربه، ومن فرط انشغاله يكون غافلا عمّن يكون معه، ولو كان أحب إنسان له فإنه لا يدري به. وساعة تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء من الأشياء، لا تذكر أولادك أو مالك، لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعود للتفكير في أولادك وعملك، وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بهذه البقعة لضاق المكان بالناس جميعا. بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}. وهنا يجب أن نفهم أن هناك فارقا بين أن يكون (الخبر) تاريخا للواقع، وبين أن يكون (الخبر) خبرا تكليفيا فلو كان {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} تاريخا للواقع لتم نقض ذلك بأشياء كثيرة، فقد وجد فيه قوم ولم يأّمَنوا.
ونحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذي حاوله جهيمان منذ سنوات قال الناس: إن جهيمان عندما اعتدى على الناس، لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن يكونوا آمنين في البيت وتساءل بعضهم، فكيف قال الحق: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً}؟ بل قال بعض أهل الانحراف: إذن مسألة دخول جهيمان إلى البيت الحرام تجعل {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} ليست صادقة! ولهؤلاء نقول: إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث، وبين إخبار بتكليف.
إن الإخبار بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام ويهيجه أو يهاجمه أحد أبدا، ولكن الإخبار التكليفي معناه: أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به، والتكليف كما نعرف عرضة لأن يطاع، وعرضة لأن يعصى، فإذا قال الله سبحانه: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} فهذا معناه: يأيها المؤمنون، من دخل البيت الحرام فأمنوه. ونضرب المثل- ولله المثل الأعلى- تقول أنت لولدك: يا بني هذا بيت يفتح للضيوف من دخله يكرم. أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت وحصوله له بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبداً أم أنك قلت الخبر وتريد لولدك أن ينفذه؟
إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت، وتلك الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف، لذلك فنحن نفهم من قول الحق: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} على أساس أنها أمر تكليفي، عرضة للطاعة وللعصيان، ومثال آخر على ذلك هو قول الله تعالى: {الخبيثات لِلْخَبِيثِينَ والخبيثون لِلْخَبِيثَاتِ والطيبات لِلطَّيِّبِينَ والطيبون لِلْطَّيِّبَاتِ أولئك مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}.. [النور: 26].
بعض الناس يقول: نجد واقع الحياة غير ذلك، حيث نجد امرأة طيبة تقع في عصمة رجل غير طيب وتتزوجه. ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة ويتزوجها، فكيف يقول الله ذلك؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول: إن الله لم يقل ذلك تأريخا للواقع. ولكنه أمر تكليفي. أَيْ افعلوا ذلك، وحكمي وتكليفي أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطيبات. فإذا امتثل الخلق أمر الحق فعليهم أن يفعلوا ذلك، وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع بنبيء بحدوث وجود طيبين لغير طيبات أو العكس.
إذن فقول الحق: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} هو خبر يراد به أمر تكليفي، فمن أراد أن يكون صادقا فيما كلفه الله به فليُؤَمن مَن دخل البيت الحرام. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العالمين} .. [آل عمران: 97].
وحين تسمع (ل) و(على)، فافهم أن الفائدة تقع على ما دخلت عليه (اللام)، والتبعة تقع على ما دخلت عليه (على). فحين نقول:: (لفلان عَلَى فلان كذا) فالنفعية لِفلان الأول والتبعة على فلان الثاني. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت}. فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله، والتبعة هنا تكون على الناس، لكن لو فطنا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا ينتفع بشيء من تكليفه لنا، فالحج لله، ولكنه يعود إليك، فما لله عاد إليك، وما عليك عاد لك.
وكل تكليف عليك فأثره لك، فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت} أن اللام الأولى للنفعية، وإياك أن تفهم أن (على) هي للتبعة، نعم إن الحج لله، ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك، وهو تكليف عليك، وفائدته تعود عليك، فالحق سبحانه وتعالى منزه عن أن يُفيد من حكم من أحكامه، وهو سبحانه حين ينزل حكما تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم عائدة عليه وعلى حياته، ولله يكون القصد والحج، لا لشيء سواه.
ولماذا يقول الحق: إن على العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام؟ لأنه الخالق وهو خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس، ولكن على المؤمن المكلف حين يجد تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم، فإن نظر إلى الفائدة من الحكم وجد أنها تعود عليه، ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة. والذي لا يقبل على الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه. تكون الطاعة شاقة عليه. والذي يقبل على المعصية ويهمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه. ولكن الطائع لو استحضر غاية الطاعة لعلم أنها له لا عليه.
ولو أن العاصي استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لا له؛ فالعاصي قد يحقق لنفسه شهوة، لكنها شهوة عاجلة، أمدها قصير، ولو استحضر العاصي العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا. ولكن الذين يرتكبون المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة، ويعزلون جزاء المعصية عنها، ولو أنصفوا أنفسهم، لا يستحضروا العقاب على المعصية في وقت الرغبة في ارتكابها. وحين يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهي منهم، وأضرب هذا المثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس.
هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينالها نقول لهذا المتشرد جنسيا: استحضر العذاب على هذا العمل، وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك ما أعده الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خارجا عن شرع الله، وأوقد له فرنا مسجوراً ومحمّياً، وقُل له: في مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة.
أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية؟ لا؛ فشهوة المعصية تضيع عندما يستحضر العذاب عليها. إن الحق سبحانه يقول: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً} والسبيل هو الطريق الموصل للغاية، والطريق الموصل للغاية عادة ما يكون مطروقا، وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق للطريق، أي سيسير عليه، هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء:
طارق، وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف.
وسبيل مطروق.
وغاية، وهي حج البيت.
وما دام الطارق سيسلك طريقا فلابد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا الطريق فكيف تتأتى هذه القدرة؟ إن أول شيء في القدرة هو الزاد، وثاني شيء في القدرة هو المطية التي يركبها، وهكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج.
والسبيل الذي يطرقه، أيكون محفوفا بالمخاطر؟ لا، بل يُفترض أن يكون السبيل آمنا. إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات، هي: الزاد، والراحلة، وأمن الطريق. والزاد عادة يخص الإنسان نفسه، ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان يعول أسرة وصغارا؟
إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعولهم إلى أن يعود. وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قال في كل تكليف: {ياأيها الذين آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ}. ولكنه سبحانه جاء في فريضة الحج بالقول الواضح، بأن الحج لله على الناس وليس لمن أسلموا فقط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب الذين كانوا يتمحكون في إبراهيم عليه السلام أن يحجوا البيت الحرام، فامتنعوا عن الحج، ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى أن يحجوا ليكون ذلك جمعاً لهم على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ويعبدوا إلها واحداً هو ربّ هذا البيت، ولكنهم امتنعوا عن الحج. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن لم يحج بدون مرض حابس، أو سلطان جائر، أو فقر وعوز، يقول في الحديث الشريف: عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً}».
ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقول الحق: {وَمَن كَفَرَ} فهل يقع من لا يحج بدون مانع قاهر في الكفر؟ هنا يقف العلماء وقفة. العلماء يقولون: نعم إنه يدخل في الكفر، لماذا؟ لأن الكفر عند العلماء نوعان كفر بالله، أو كفر بنعمة الله، ومثال ذلك قوله- جل شأنه-: {وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع والخوف بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ}.. [النحل: 112].
أو هو الكفر، كأن يموت الإنسان يهوديا أو نصرانيا، وهنا نقول: انتبه، لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى. إن المسألة التكليفية يوضحها الحق بقوله: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت}. فهل تعارضون في هذا التكليف؟ أو تؤمنون به ولكن لا تنفذونه؟
إن القضية التكليفية الإيمانية هي {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت} فهل أنت مؤمن بها أو لا؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين بـ(نعم).
ولكن الموقف يختلف مِنْ مؤمن إلى آخر؛ فنحن نجد مؤمنا يحرص على أداء الحكم من الله، وهو الطائع، ونجد مؤمنا آخر قد لا يحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا.
ونجد في هذا الموقف أن الكفر نوعان، هناك من يكفر بحكم الحج، أي من كفر في الاعتقاد بأن لله على الناس حج البيت، وهذا كافر حقا، لكنْ هناك نوع آخر وهو الذي يرتكب معصية الكفران بالنعمة؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد، ومن راحلة، ومن أمن طريق، ومن قدرة على زاد يكفي من يعولهم إلى أن يعود، وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج. لذلك قال بعض العارفين لو أن أحدهم أُخْبِر بأن له ميراثا بمكة لذهب إليه حبواً.
إذن فقوله تعالى: {وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت} هي قضية إيمانية، فمن اعتقدها يبرأ من الكفر، ومن خالفها وأنكرها فهو في الكفر. ومن قام بالحج فهو طائع، ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاصٍ.
ولننظر إلى دقة الأداء القرآني حين يقول الحق: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العالمين}. قد يقول قائل: ولماذا لم يقل الله: ومن كفر فإن الله غني عنه؟ وقال: {فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العالمين}؟ ونقول: إنّ الله غنيٌّ عن كل مخلوقاته، وإيّاك أن تفهم أن الذي لم يكفر وآمن، وأدى ما عليه من تكليف، أنه عمل منفعة لله؛ إن الله غني عن الذي أَدّى وعن الذي لم يؤد، إياك أن تظن أن من أدّى قد صنع لله معروفا، أو قدم لله يدا؛ {فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العالمين} عمن لا يفعل، وعمن يفعل. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: {قُلْ ياأهل الكتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله...}.
المصدر: موقع نداء الإيمان
موضوعات متعلقة:
- تفسير الشيخ الشعراوي لمكان اول بيت لله على الأرض
- تفسير الشيخ الشعراوي لمتبعى ملة إبراهيم
فيديو قد يعجبك: