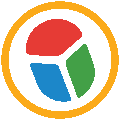- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة
تسجيل الدخول
حتى لحظة كتابة هذا المقال شاهدت أربعة أفلام من بين ١٧ فيلما تشارك بالمسابقة الرسمية - إضافة إلى خمسة أخرى بالبرامج الموازية - بمهرجان برلين التاسع والستين المنعقد في الفترة من ٧- ١٧ فبراير، وهي الدورة التي يختتم بها ديتر كوسليك، المدير الفني للمهرجان، رحلته بعد ١٨ عاماً في منصبه الذي شغله منذ ٢٠٠١، حيث يعقبه في تولي إدارة المهرجان كل من السينمائية الهولندية مارييت ريسنبك والإيطالي كارلو شاتريان، المدير الحالي لمهرجان لوكارنو السينمائي.
رغم الهجوم والانتقادات التي تعرض لها كوسليك - البالغ من العمر٧٠ عاماً - خصوصا من الصحافة الألمانية في السنوات الأخيرة بسبب ما يعتبرونه نقص الجودة الفنية للمهرجان، لكن على صعيد مغاير وبشهادة آخرين من المتابعين للمهرجان منذ توليه منصبه قد ترك بصمته القوية، ومنها تدعيم موقف ومكانة الفيلم الألماني في المهرجان ومواصلة تنوع البرنامج والإقبال المتزايد للجمهور، مثلما يبدو أنه سيختتم مهمته بدورة متميزة وهو ما يشي به مستوى الأفلام التسعة التي شاهدتها في يومين فقط.
صحيح أننا مازلنا في بداية المهرجان، وعادة المهرجان لا يكشف عن جواهره الفنية والسينمائية منذ البداية، لكن على الأقل حتى الآن هناك تميز واضح لفيلمين على الأقل من الأربعة المشاركة بالمسابقة، فيلم «من أجل الله» للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، والفيلم الألماني «تصدع النظام» واللذين يتنافسان بقوة على الذهب الذهب الذي ستمنحه لجنة التحكيم الدولية برئاسة الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.
سينما المؤلف والقضية
في العملين رغم اختلاف الموضوع يتصدر السيناريو خشبة المسرح ويُصبح هو البطل الأساسي والعمود الفقري، والعملان ينتميان لسينما المؤلف. صحيح يكتسب الفيلم الأول قيمته من قضية خطيرة ظلت لسنوات "تابوه" ممنوعاً فتح ملفاته الشائكة، لكن خطورة القضية أو كونها مقتبسة من وقائع حقيقية ليسا وحدهما سبب قوة الفيلم، وإنما أسلوب البناء السينمائي التراكمي للتفاصيل، في البحث عن الشخصيات وغرسها بشكل هارموني يجعلنا غارقين معهم منفصلين عن واقع الصالة حتى لحظة الختام.
يبدأ فيلم «من أجل الله» - الذي أثيرت المشاكل من حوله في فرنسا ورفعت ضده قضايا تطالب بمنع عرضه - من ألكسندر، رجل أربعيني متدين، متزوج ولديه عائلة كبيرة من الأطفال، يكتشف أن القس الذي انتهك حرمة جسده في طفولته واغتصبه مرات عدة لايزال يعمل مع الأطفال، فتعود به الذاكرة للوراء، وتستعيد معها بشاعة الأثر المؤذي حيَّة نابضة إلى روحه التي يتفجر فيها الغضب وعدم القدرة على التسامح، وتبدأ رحلة البحث عن الخلاص، لكنها تصطحب معها صراعات أخرى، فلن يقتصر الأمر على الصراع النفسي، حول ما إذا كانت المقامرة بفتح هذ الباب ستجلب الكثير من المشاكل له ولعائلته وفي مقدمتهم أطفاله الذي يتنازعه تجاههم أمران؛ الخوف أن يمروا بنفس التجربة فيريد حمايتهم وتوعيتهم خصوصا أنهم عائلة متدينة منتظمة في الطقوس الكنسية، والأمر الآخر الخوف عليهم من آثار تفجير قضيته، إضافة إلى الخوف على مستقبله بعمله، وعلى عمل زوجته، وتأثير ذلك على استقرارهما العائلي والحفاظ على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشان في ظله، متطرقاً إلى نظرة أطفاله وتعاملهم مع الأمر، وإلى نظرة أقاربه، وردود فعل الوالدين.
كرة الثلج بين المركز والأطراف
يتخذ السيناريو من شخصية ألكسندر نقطة الانطلاق التي من خلالها يبدأ البحث عن الضحايا الآخرين، خصوصا بعد أن شعر بأن كبار رجال الكنيسة يتلاعبون به، ويحاولون تغطية الأمر، ووأده، وأنهم كانوا يعلمون بتلك الإساءات والتحرش الذي تعرض له الأطفال، في إدانة واضحة لتلك المؤسسة.
خلال رحلة تجميع عدد أكبر من الضحايا التي لن تقتصر على ألكسندر تصبح القضية مثل كرة الثلج أحياناً التي تتضخم عندما تتنقل من شخص لآخر. لكن سرعان ما يُصبح كل شخص هو كرة الثلج القائمة بذاتها التي في لحظة ما تندمج مع كرات الثلج الأخرى لتشكل كرة أكبر لها دويّ أكثر وقعاً.
هنا، يتردد بعض الضحايا، نرى أنواعاً منهم على مدار الفيلم وحتى نهايته إذ نشاهد بعضهم لايزال خائفاً من الإعلان عما تعرض له. البعض يقاوم خوفه، البعض الآخر يحاول الانسحاب لكن إرغامه على الشهادة بعد اكتشاف وثائق تقدمها عائلته للبوليس تضطره لعدم الانسحاب وتسحبه لأرض الجرأة وشجاعة الاعتراف ثم لاحقاً يلعب دوراً جوهرياً.
اللافت في بناء الفيلم، أنه أثناء البحث عن ضحايا هذا القسيس يأخذنا المخرج المؤلف في رحلة استكشاف للآثار النفسية المدمرة لحوادث الاغتصاب والتحرش في الطفولة وعواقبها النفسية والجسمانية البشعة والتي لا تترك الإنسان في الكبر، ثم مع كل شخصية يترك لنا المجال لنعايش حالتها وعلاقتها بمحيطها الإنساني، قبل أن يعود بنا وبها إلى المركز مرة ثانية ليقوم بدمجها مع الشخصيات الأخرى فنراها في سياق المجموع. وأثناء ذلك يكشف الفيلم - عبر المقارنة أيضاً - تفاوت ردود فعل الآباء والأمهات وحتي الأخوة والعلاقات الإنسانية المعقدة المغموسة في الغيرة أحياناً سواء بين الأزواج أو الأخوة، بشكل يُؤكد كيف كان الأمر "تابوه" مرعبا وصادما - في تلك المجتمعات المتدينة رغم تواجدها في مجتمع حر ليبرالي مثل فرنسا - وأن البعض لم يكن يعرف كيف يتعامل مع الأمر، حتى إنه اكتفى بالصمت.
تصدع النظام
أما فيلم «تصدع النظام» للمخرجة الألمانية نورا فينجشايدت فهو فيلم على الأقل في نصفه الأول شديد الوطأة ويصعب على المتلقي الصمود أمامه بسبب شخصية الطفلة ذات السنوات التسع المتفجرة بطاقة العنف، حيث إن النظام يجبرها على أن توضع تحت الحماية في مؤسسة علاجية بسبب سلوكها العنيف. الطفلة لا تقبل بأي ترويض، وهي تشبه النمرة المتوحشة، التي تصرخ بأسلوب هستيري، لكن مع التدرج في بناء التفاصيل، وتكشف الشخصيات ندرك أنها تفتقد عاطفة الأمومة، أنها شديدة التعلق بوالدتها، وتفتقدها. أنها تتحول لشخصية مسئولة مع أخوتها الصغار ومع الآخرين عندما يجتمع شملها بالأم، لكنها تتحول فجأة إلى وحش كاسر عندما يتم انتزاعها من ذلك الحب الذي يُعيد إليها سلامها النفسي.
هنا، يميز الفيلم عدة أمور، البناء المثير، فالأحداث لا تهدأ أبداً، وكلما تصرفت الطفلة بشكل طبيعي وابتسمت وضحكت ولعبت مع الآخرين، وبدت وكأنها تستعيد الإحساس بالمسؤولية لكن أقل تصرف - في مشهد تالي سريع - يسحب منها الإحساس بالأمان والعاطفة يجعلها تتحول إلى مجرم قاتل في أقل من طرفة عين.
الجانب الآخر، البناء النفسي للشخصيات، الذي يُؤكد مهارة وذكاء الإحساس الذي تتمتع به المخرجة فكأنها قامت بعشرات الدراسات حول سلوك تلك الطفلة والنوبات التي تصيبها في مختلف حالاتها، كذلك شخصية المدرب الذي يحاول إقناع الطفلة بالالتحاق بالفصل الدراسي للتعلم، والذي ينجح بدرجات فتتعلق به وتعتبره أباها، لكنه رغم تعاطفه معها يُدرك خطورة التورط معها في عاطفة الأبوة، ويرفض دوما مجاراتها في ذلك ويحسم الأمر بشكل شديد الوضوح، بأنهما ليسا صديقين وأنه ليس أباها، فهو لديه عائلته، زوجته الحامل وطفلته.
هنا بلقطات بسيطة جدا ترسم المخرجة المؤلفة الخط الفاصل بين شخصية المدرب وزوجته، بين البصيرة والنظرة العملية المدركة لمخاطر التورط في عالم هذه الطفلة وبين الزوجة التي تنساق عاطفياً وتكون أقل تساهلا وتدفع الثمن وكأنه تحذير من مغبة التعاطف الإنساني والخروج عن القانون والنظام، لكن الفيلم في ذات الوقت يُؤكد فشل ذلك النظام في توفير العلاج والحماية لتلك الطفلة.
الجميع يتنصل من المسؤولية
في مجتمع الرفاهية هذا يتنصل الجميع من المسئوولية إزاء الطفلة، الأم تتخلى عنها خوفاً من مواجهة إحدى نوبات الغضب والصراخ والعنف، تتحجج بأنها ليس لديها عمل مستقر، وبأنها تخشى على طفليها الآخرين، المدرس لديه دور محدد ووظيفة يقوم بها ولا يرغب في المغامرة بالمزيد، الآخرون يرفضون أن تصبح الطفلة فردا في عوائلهم، أو أن يتحملوا مسئوليتها، ولا أحد يستطيع أن يلومهم إذا كانت الأم نفسها قد تخلت عنها.
لكن، المدهش أن النظام المؤسسي الذي أقامته الدولة نفسها غير قادر على التعامل مع هذا الطفلة ومن ثم يُفكر في إرسالها إلى كينيا. أمر شديد السخرية، والمرارة. مجتمع الرفاهية غير قادر على حماية أفراده، غير قادر على توفير الأمان العاطفي والإنساني لأطفاله المرضى، نتيجة فقدان العواطف، فيسعى إلى نفيهم خارج المجتمع، بل وتصديرهم إلى مجتمعات فقيرة مطحونة. وليس أبلغ من مشهد الختام حين تنطلق الطفلة في أرجاء المطار في محاولة للهرب من مصيرها والجميع يجري من خلفها قبل أن تختتم المخرجة بلقطة ارتطام الطفلة بالسقف الزجاجي الذي يتصدع في دلالة واضحة للبناء الزجاجي لهذا المجتمع الذي كشفت قضية هذه الطفلة مدى هشاشته.
إعلان