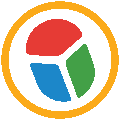- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة
تسجيل الدخول
اختار المخرج والمونتير أحمد عبدالله السيد أن يُهدي أحدث أفلامه «ليل خارجي» إلى روح الناقد السينمائي سمير فريد الذي ساند أجيالاً مختلفة من صناع السينما بدءًا من جيل الواقعية الجديدة، وصولا إلى شباب السينما المستقلة، ومنهم مخرج «ليل خارجي»، وكذلك منتجته هالة لطفي.
إنها لفتة إنسانية مؤثرة. اعتراف بالجميل والدور الذي قدمه ناقدٌ وصحفيٌ سينمائيٌ يصعب أن يتكرر.
في تقديري الشخصي- أيضاً- أن الفيلم الذي كتب له السيناريو والحوار شريف الألفي- بتفكير وإعادة كتابة مع المخرج وفق تصريحه بأحد الحوارات المنشورة- ينتمي للواقعية الجديدة التي طالما دافع عنها سمير فريد، وأتاح لمخرجيها فرصاً لإنتاج وتحقيق أحلامهم، خصوصًا عندما كان مستشاراً لشركة حسين القلا.
والجميل أن «ليل خارجي» عمل شديد الواقعية بأجوائه وتصويره للأماكن المختارة بشكل جديد، فيه جمال وبكارة، رغم الفقر، لكنه مصور بطريقة تُظهر جمال الصدأ، فالديكور بتفاصيله وشكله كأننا نكاد نشم رائحته، وروح شخصياته بصدقها وتلقائيتها في الأداء وفي كلمات الحوار كأننا نعيش روح هؤلاء الأبطال، كأننا نعيش مصر، في شوارعها وحواريها، على نيلها وكباريها، وطيورها المحلقة، وأبنائها المطحونين، الصامدين، «السلكاوية»، بخفة دمهم، وبلطجية بعضهم.
إنها الرغبة في البقاء
في «ليل خارجي» تكثيف لمشاكل مجتمعنا، بكثير من عيوبه وضغوط الحياة فيه، عن الممنوعات، الرقابة، رسمية ومجتمعية. مع ذلك تخرج من الفيلم وأنت في حالة حب لأبطاله، تتعاطف معهم، والمدهش أنك تشعر بحب لهذا البلد، وتراه قادرا علي أن يستمر رغم كل شيء، كأن التصوير السينمائي هنا ينتقد وفي نفس الوقت يُذكرنا بأشياء جميلة هنا خصوصا في اللقطات الواسعة المرتفعة، كأن صناع العمل أخذوا بمبضع الفنان قطاعًا عرضيًا من المجتمع فشرَّحوا لنا صورة الشارع بكثير من تفاصيله، بجمالياته وبتناقض ناسه الذين يستخدمون الألفاظ الخادشة للحياء لكنهم يعترضون علي نشرها في كتاب، عن الرقابة المجتمعية التي تتستر وراءها الرقابة الشرعية، سواء في لافتة ممنوع التصوير، أو حبس الكاتب الروائي، أو ممارسة دور الرقيب على من يمارسون الحب، مما يجعلنا نستدعي بيتًا من قصيدة للشاعر العراقي مظفر النواب:
قتلتنا الرده، قتلتنا الرده
قتلتنا
إن الواحد منا
يحمل في الداخل ضده.
المراوحة في السرد
يسير خط السرد بالتوازي المتداخل تقريباً بين الفيلمين. فيلم "حاوي" يمثل الواقع الذي يعيشه الأبطال، وفيلم آخر في خيال المخرج «مو». اختار أحمد عبدالله السيد أن يبدأ شريطه من الخيال والرومانسية قبل أن يرتد بنا إلى الواقع الذي يختتم به، أيضاً شريطه السينمائي عندما يعود الشاب «مو» من تجربته مع فتاة الليل والسائق ويدخل بيته متسائلاً عن معني السعادة: هل الناس سعداء؟! متطرقاً للاشتباك بين العام والخاص، ثم يفتح شباك غرفته الموارب على مصراعيه كمن يفتح نفسه على العالم، كأنه قرر أن يكون سعيدا مهما كانت الضغوط كما يفعل الآخرون.
أعجبني المشهد، لكن لم يعجبني المونولوج فيه، لأن المعنى كان واضحاً بدون هذه الخطابة والمباشرة.
ما بين البداية والختام يظل المخرج يراوح بين العالمين- عالم «مو» وعالم الشاب المهاجر غير الشرعي- بانسيابية الذوق على صفحة النهر، برقة مدهشة في الجمع بين أسلوبين في السرد، محطماً الحواجز بينهما، مثلما حطم الحاجز بين النخبوي والشعبي، بين رومانسية الصورة السينمائية الخالية من الحوار بالفيلم المتخيل، وبين شعوبية وديموجاجية بعض أفراد فيلمه الحاوي أو المُؤطر للحكاية، كأنما يريد أن يقول إنها الحياة لا تخلو من الاثنين، ليس صحيحاً أن أحدهما ضد للآخر، وليسا منعزلين تماماً عن بعضهما، ربما يكونان وجهين لعملة واحدة هي الإنسانية، التي يُجسدها هنا الإنسان المصري وهمومه المشتركة بكل أطيافه وطبقاته، فعوالمه مزيج من الواقعية والرومانسية.
غياب وحضور
يبدأ الفيلم من لقطات لشاب ملامحه مصرية بامتياز- الممثل علي قاسم- جالس يتأمل البحر، على مركب موتوره دائر، وكأنه دلالة على العقل المشغول الشارد في فكرة الهجرة، يُؤكدها تكاثر طيور النورس تُحلق في الأجواء.
في اللقطة التالية تنتقل الكاميرا إلى مكان تصوير أحد الإعلانات التجارية التي يخرجها «مو».
أما اللقطة السابقة، فكانت لحظة تخيلية لفيلمه الجديد عن «الهجرة غير الشرعية» كأنه حصن يحتمي فيه من مخالب الواقع وكل وسائل القهر، كأنه العلاج النفسي الذي ينفث فيه غضبه، وليحافظ على هدوئه وسلامه الداخلي.
اللافت أن جميع لقطات الفيلم المتخيل تم تصويرها بشاعرية رائقة، من دون أن نسمع كلمة حوار واحدة، باستثناء المؤثرات الصوتية كأزيز مروحة السقف، وضجيج موتور المركب، أو القليل من مؤثرات الواقع الحي أثناء النقلات بين العالمين.
وسيظل السرد طوال مدة الفيلم يسير بالتوازي بين ذلك الخيال وواقع الحياة في بقايا ذلك النهار وطوال تلك الليلة، فالخيط الرئيسي الذي يربط الحكاية في عُقد جميل متنوع الحبات هو المخرج «مو»، فكأنه يحكي عن نفسه، من خلال ما نراه في الآخرين- رغم أنه أقل الشخصيات التي تتحدث عن نفسها، لكن ردود فعله إزاء أخلاقيات وسلوكيات وردود أفعال الآخرين الذين يتواجدون في محيطه كانت تشي تدريجيا بملامح شخصيته.
الأعمال الرومانسية تحتاج إلى شريط الصوت
أعتقد أن أحمد عبدالله السيد- صاحب «هوليوبوليس»، «ميكروفون»، و«ديكور»- كان يُفكر في تقديم فيلم جماهيري من دون أن يتخلى عن القيمة الفنية والفكرية المنسوجة برشاقة متوارية ومهارة في تفاصيل اللغة السينمائية.
يتبدى هذا من خلال توظيفه شريط الصوت، وخفة ظل الممثلين في عدد من المواقف التي أضحكت جمهور قاعة العرض، وجماليات تصويره للأحياء الشعبية بالقاهرة، وللريف وناسه بطزاجتهم وضحكاتهم وباختياره لأماكن فيها بكارة لافتة، لكنه جعل حركة الكاميرا اقتصادية جدا، للتركيز علي روح الإنسان وأعماقه. تتحرك الكاميرا مرات قليلة، وقت الضرورة الدرامية فقط، مثلا الاهتزاز وقت الخناقة بين المخرج والسائق. أو استخدام الحركة العرضية في مرات أخرى، لكن في أغلب اللقطات تظل الكاميرا ثابتة، مع تنويعات للزوايا والأحجام وإن كانت تميل إلى اللقطة المتوسطة والمقربة التي تمنحنا فرصة لتأمل الوجوه وقراءة بواطن الشخصيات.
الشخصية الأكثر بروزاً هي شريط الصوت، فهو شديد الثراء والتنوع، بل يُعد أحد أبطال الفيلم، وأهم المداخل الجمالية لقراءة الشخصيات، ويحتاج لإعادة تأمله ودراسته، فهو خصب بالأغاني الشعبية، وعبدالوهاب وأم كلثوم، وشيرين، وأيضاً الأناشيد الصوفية.
تتجلي موهبة المخرج في قدرته على توظيفه سينمائياً للتعبير عن بواطن الشخصيات، وعوالمها، وليس فقط خلفيتها الاجتماعية والثقافية، أو لإضفاء حالة من البهجة في عدد من مناطق الفيلم قبل أن تسقط في فخ الكآبة.
شريط الصوت أيضاً أسهم في ضبط الإيقاع، وخلق هذا الحس والجو الشعبي المسيطر على روح الفيلم أكثر من ذلك النخبوي، لكن المخرج أتاح لحظات من الصمت، كي تتنفس المشاهد- إن جاز التعبير- أو لنلتقط نحن أنفاسنا، كأنه يُلَحّن نوتة موسيقية تتحاور فيها الآلات دون أن تطغى آلة على أخرى، فلم يكتفِ بترك لحظات الصمت أحياناً في الجزء الواقعي بكل ثرائه، لكنه ظل يختلسنا إلى لحظات صمت أخرى مشحونة بالانفعالات المكتومة مع شخصيّتيه الخياليتين- بطلي فيلمه القادم عن الهجرة غير الشرعية.
نجوم الأداء
صحيح أنه في بعض اللقطات يلتبس علينا الأمر، فلا نعرف هل حقاً يُعبر شريط الصوت- خصوصا الأغاني- عن مكنون الشخصية، أم أن الشخصية تلجأ إليها هروباً من المشاحنات، كمُسَكِنْ أو ثغرة للإفلات، فتهاني مثلاً عندما تسمع أغنية شيرين «يا ليالي» بصوت خافت تطلب منهما- المخرج والسائق- فجأة أن يرفعا صوت الكاسيت، وتخرج رأسها من سقف السيارة، وتشرد أكثر مما تبتهج بالأغنية، فهل كانت تهرب مؤقتاً من الضغط النفسي، تأخذ لحظة من الهدنة، أم أن الأغنية تذكرها بالحبيب الذي غاب عنها، أو الفارس الذي تنتظره وتحلم به.
أياً كان الإحساس الكامن في أعماقها فهو مفتوح على تأويلات عدة، فالأهم أن الأغنية رغم ما بها من شجن، فهي تناسب تماماً روح شخصية تهاني: «يايجي لي يا أجي له، ويخلي لبعده نهاية».
تحية أخيرة لكل من شارك في أي تفصيلة بهذا الفيلم، ومن فريق التمثيل أخص كريم قاسم ومني هلا، والشاب علي قاسم، لأن أدوارهم كانت الأصعب، خصوصا كريم قاسم كان الأفضل، والأمهر؛ كان أداؤه- كما يُقال في فنون الأداء- «تحت المطلوب» بقليل، لكنه في رأيي هو المطلوب بدقة. ممثل موهوب جدا. تأملوا إيماءاته، وتعبيرات الوجه الشحيحة المتوارية- المتناسقة مع بنيانه الجسدي ومع شخصيته- والنظرات الكاشفة لمشاعره، إنه الأداء الخافت المتواري، لكنه المعبر عن أعماق الشخصية. كذلك منى هلا في أداء شخصية توتو، رغم الصوت العالي أحيانا كفتاة من حي شعبي، لكنها في لحظات الصمت قدمت مجموعة من أهم مناطق التعبير الأدائي بالفيلم، وأثناء الخناقة جاء الصوت بعيدًا عن الارتفاع عندما كشفت حقيقة البلطجي، فنطقت بهدوء وأدب لا يخلو من المكر البليغ.
إعلان