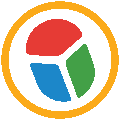- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة
تسجيل الدخول
عبر آلاف السنين ظل نهر النيل يجري في مسارات محددة ممتدا من أقصى الجنوب مخترقا السهول والهضاب حاملا طميه وخيره وملحه ليصب في أقصى الشمال حيث المصب على البحر المتوسط .
وإلى وقت قريب ومع تطور العلوم الزراعية والهندسية المتعلقة بالري والصرف، أخذ الخبراء المصريون في إعادة التفكير في كيفية الاستفادة من هذا الكم الهائل من المياه المهدرة والتي تذهب سدىً لتصب في البحر والتي تقدر بنحو عشر إيراد النهر وقت الفيضان.
وبهذا اتسع أفق الدورة الزراعية المصرية سواء بإنشاء السدود على مجرى النهر بدءًا من سد أسوان وقناطر نجع حمادي وقناطر محمد على مرورا بالسد العالي وانتهاء بمشروع توشكي العملاق .
وبهذا خلق النهر بيئته المصنوعة -وليست المصطنعة- على حد تعبير أستاذنا الراحل جمال حمدان.
وبالمثل منذ عرفت مصر نظام التعليم المدني الحديث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ظل أطفال مصر وطلابها طوال شهور الإجازة الصيفية التي تقارب المائة يوم نهبا للفراغ وهدر الطاقة وباستثناء أطفال الطبقات الفقيرة الذين يستثمرون هذا الوقت الطويل في العمل لمساعدة آسرهم ماديا أو أبناء الطبقات الثرية الذين يمضون إجازاتهم في النوادي والمصايف فإن أبناء الطبقات الوسطي لم يحظوا باهتمام مؤسسي تتولاه أجهزة الدولة وفقًا لمخطط قومي يستهدف تفجير طاقتهم واكتشاف ذوي المواهب والمبدعين منهم، وهكذا ظلت طاقة "الكتلة الحيوية للمجتمع والدولة" والممثلة فيما يزيد على ¼ سكان البلاد في سن الإبداع والانطلاق مبددة لا تحظى باهتمام أحد ولا يقترب منها أحد.
وزاد من صعوبة الأمر أن ما جرى من تغييرات عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصرية والعربية بعد عام 1973 والانعكاسات الخطيرة والضارة التي أوجدتها هذه التغيرات على أنساق القيم والمفاهيم والسلوكيات بين الأجيال الجديدة، وحجم التحديات المصاحبة بالضرورة للتسوية السياسية للصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل، وكذا التغييرات في البيئة الدولية وعمليات العولمة قد أضاف لعوامل الانكشاف عناصر جديدة بما يستدعي التعامل المرن والمتطور مع الأجيال الجديدة.
وبالمقابل شهدت الجهود المخلصة والدؤوبة في مطلع التسعينيات دفعة جديدة، وأثارت بقدر جرأتها وأحيانا اندفاعها مقاومة عنيفة وشرسة من جانب قوى عديدة ومتنوعة.
المهم أنه في إطار هذه الجهود جاء المؤتمر القومي الأول لرعاية واكتشاف الموهوبين في أبريل من عام 1992 إدراكا لطبيعة الإبداع والموهبة اللتين لم تعدا مجرد ضربة حظ، أو محض مصادفة سعيدة بقدر ما باتت نبتا طبيعيًا لجهود مؤسسية متكاملة ومنظمة وصبورة، بيد أن هناك منطقة في هذا الجهد ما زالت مظلمة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها وهو ما سنحاوله في هذا المقال.
فمما لا شك فيه أن أية استراتيجية ينبغي أن تستند وتتأسس على ثلاثة ركائز أساسية هي:
الأولى: تحديد لطبيعة التحديات أو التهديدات التي تواجه الأمة ككل، سواء من مصادر داخلية أو خارجية، وسواء كان ذلك في قطاع من قطاعات الدولة كالتعليم أو الإعلام أو الثقافة.. إلخ، أو على المستوى القومي الشامل .
الثانية: تحديد للأهداف المطلوبة أو المرغوبة في ضوء رصد دقيق للموارد والإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه التحديات أو التهديدات .
الثالثة: تتأسس على ذلك مجموعة من السياسات التنفيذية، وفقًا لبرامج عمل زمني محدد لبلوغ هذه الغايات وتحقيق تلك الأهداف.
يأتي مشروعنا بشأن "برنامج قومي للنشاط الصيفي" بمثابة أحد الزوايا الأساسية لاستكمال الجهود المبذولة للخروج من حالة التيه والضياع الذي يعانيه أطفال مصر في مراحل التعليم المختلفة في ظل بيئة تعليمية واجتماعية لا يمكن احتمالها أو استمرارها؛ لأن استمرارها بأكثر من هذا كان يعني انهيارًا شاملًا لكامل البناء النفسي والسلوكي والثقافي والأخلاقي لثلاثة أجيال على الأقل .
وقبل أن نتعرض تفصيليًا "لبرنامج النشاط الصيفي" علينا أن نتوقف بالنقد والتحليل لأداء النظام التعليمي وأوضاعه الراهنة ومحاولات إصلاحه لنتبين حيوية "برنامج النشاط الصيفي" باعتباره أداة لا غني عنها لسد ثغرة إبليس في منظومة بنائنا التعليمي والوطني .
التعليم.. والتربية.. أدوار متخاصمة:
لا ندري على وجه اليقين متى بدأ الانفصال والتباعد بين الدور التربوي للمدرسة ودورها التعليمي.. هل كان ذلك بعد عدوان 5 يونيو عام 1967، حينما تآكلت وتضاءلت الاعتمادات المخصصة للتعليم والأنشطة المدرسية في الإنفاق العام، وتوجيه الاهتمام إلى إعادة بناء القوات المسلحة، وتركيز جل الأنظار على معركة التحرير القادمة أو كان ذلك بعد هجمة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 وبداية الانقلاب الشامل في كافة الأبنية الاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع والدولة .
بيد أن القدر المتيقن منه أن طلاقا بائنا قد بدا واضحا بين الدور التربوي والدور التعليمي منذ منتصف السبعينيات وأخذ يزحف بصورة مفزعة منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا الراهن .
والدور التربوي الذي نعنيه ليس هو التلقين الأخلاقي للطلاب -على أهميته- خاصة بعد أن زحفت سلوكيات الدروس الخصوصية، فانهار بها ومعها قيم القدوة والأستاذية، ولم يبق من يعظ ولم يصمد من يلقن الأخلاق، بل نقصد بالدور التربوي ذلك الأداء الجماعي أو الفردي الإبداعي لطلاب المدارس، سواء في صورة أنشطة رياضية أو مسابقات فنية وموسيقية ومسرحية أو في أطار التنافسات العلمية… إلخ .
لقد استقرت دراسات علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الطفل على أن الأطفال يتحركون في تنشئتهم الاجتماعية والسلوكية والقيمية في دوائر أربعة متداخلة ومتكاملة هي (1)
1- دائرة الأسرة بكل ظروفها ومشاكلها .
2- دائرة المدرسة بكل اختلالاتها وأحوالها .
3- دائرة الصحبة أو الأصدقاء، وما يصاحبها عادة من احتمالات للخطر .
4- ثم دائرة أوسع يمثلها النسق الإعلامي والثقافي والقيمي في المجتمع وفي القلب منه جهاز التليفزيون .
ويتفاوت تأثير كل دائرة من هذه الدوائر وفقا لظروف التنشئة الاجتماعية من طفل إلى آخر ومن فئة اجتماعية وعمرية إلى أخرى، ومن الملاحظ أنه قد برزت تطورات جديدة في مساحة التأثير الخاصة بكل دائرة من هذه الدوائر خلال العقدين الماضيين .
ففي البدء كانت الأسرة هي صاحبة التأثير الأول والممتدة لسنوات طويلة من عمر الطفل؛ فمنها يستمد الطفل قيمه ورموزه، وفيها تتشكل مدركاته وأحاسيسه، وعبرها تتأسس علاقاته مع الآخرين من أقربائه ومع الأشياء. ثم مع النمو المتزايد واتساع نطاق التعليم زاحمت المدرسة الأسرة في دورها التربوي ثم شيئا فشيئًا،
اكتسحت أجهزة الإعلام المرئية - خاصة جهاز التليفزيون - الدائرتين السابقتين، وأصبح بما يقدمه من أشخاص ورموز وقيم عبر الأعمال الدرامية المحلية أو الأجنبية منبعًا ومصدرًا لكثير من القيم والمفاهيم والسلوك لأعداد هائلة من الأطفال والنشء والشباب .
وإذا كانت بعض المؤسسات بالدولة قد ركزت نظرتها أكثر على الأسرة باعتبارها "الحضانة الطبيعية" للمرحلة المبكرة من التنشئة الاجتماعية للطفل (2)؛ فإننا نذهب منحني مختلفًا بالتأكيد على دور "المدرسة" باعتبارها "معمل المدركات" بالنسبة للطفل، ففي المدرسة تتفتح عيونه على حروف المعرفة، وفيها يستمد قدوته ورموزه الأولية؛ وعبرها يتفاعل جهازه العصبي والنفسي مع الآخرين ليكون أولى العلاقات الاجتماعية والأصدقاء .
والمدرسة فوق كل ذلك مكان "التجميع الجبري" للمئات من الأطفال الذين تتقارب أعمارهم، وتتوحد اهتماماتهم ومن ثم فهو المكان الذي لو أحسن التعامل معه من المجتمع وأجهزة الدولة فسيكون مركز وبوتقة التشكيل والصياغة الوجدانية والمعرفية .
وتسهم الفترة الزمنية الطويلة نسبيا التي يقضيها الطفل في المدرسة ( 9 ساعات يوميًا في حالة اليوم الكامل) طوال ستة شهور كاملة؛ في حيوية وأهمية تركيز أجهزة الدولة التربوية والتعليمية في العمل داخل المدارس ومن خلالها، ومن هنا خطورة تلك الأفكار المستحدثة التي أتى بها بعض المهندسين في قمة السلطة بشأن تغليب عناصر التقنية الحديثة مثل التعليم عن بعد والتابلت وغيرها من الوسائل الفنية على حساب التواجد الحي بالمدرسة كحيز اجتماعي بأكثر من كونه حيزًا جغرافيًا.
وإذا كانت المدرسة بهذا المعنى هي ملتقى ثلاث عمليات إنسانية تمثل كيمياء التنشئة الاجتماعية وهى:
- المدرس وسلوكياته .
- المعارف العلمية والفكرية وأهميتها .
- الأنشطة التربوية والفنية كمهارات مكتسبة .
فإن المؤكد أن هذه المكونات الثلاث قد تعرضت للتآكل والانهيار طوال الخمسين عامًا الماضية وتحديدا منذ عام 1967 .
إعلان