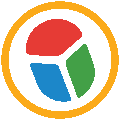- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة
تسجيل الدخول
حديقة الأورمان، وما أدراك ما حديقة الأورمان! تاريخ ثري. جمال أصيل. ثقافة عميقة. لكنها أيضًا شاهد عيان على انهيار كامل ودمار شامل لا يخلوان من آثار طفيفة لبقايا آدمية قد يمكن إنقاذ بعضها في حال تم مد يد العون الأخلاقي والإسعاف السلوكي مع وضعها في العناية الثقافية المركزة فترةً خوفًا من أن ترتد إلى قبحها وتنتكس إلى سابق بؤسها.
بؤس حقيقي– رغم روعة أزهار الربيع ورونق شجيرات من قلب الريف المصري إلى عمق أوروبا وآسيا وإفريقيا- ينضح به كل ركن من أركان إحدى أكبر الحدائق "النباتية" (سابقًا) في العالم المتحول الكثير من أرجائها لمقالب زبالة متجددة، وجمهورية بلاستيك وحديد لا ينافسها في القبح سوى الأبراج الخرسانية المؤلمة التي تطبق على أنفاس الحديقة من الخارج.
الحديقة التي أنشأها الخديوي إسماعيل في عام 1875، وجلب إليها أشجار فاكهة وزينة ونباتات نادرة من كل أنحاء العالم لتتحول إلى تحفة نباتية مسرة للعين وبهجة للعقل وفرحة للقلب، تقف اليوم لتكون شاهد عيان على ما جرى للمصريين على مدى عقود. فالحديقة التي كانت تلقب حتى سنوات قليلة مضت، وذلك قبل الهجمة العشوائية الغوغائية الشرسة في أواخر سبعينات القرن الماضي، بـ"كنز نباتات العالم" باتت تشبه عزيز قوم ذل. ما تبقى من أشجارها البازغة، ولافتاتها المعدنية الأنيقة (التي لم تسرق أو تنهب أو تدمر بعد) تطل على الزائرين ولسان حالها يضرب كفًا بكف. فكيف يكون أولئك الذين يتسلقون جذوعها التاريخية التي لا تقدر بثمن ليحفروا قلبًا عليه سهم يؤشر إلى أن "حازم" يعشق "شيماء"، أو لينشروا دين الحق حافرين بأظافرهم تارة، ومطاويهم تارة "صلي على رسول الله"، هم أنفسهم أحفاد رجال ونساء ارتادوا الحديقة حتى سنوات قليلة مضت، وهم مقدرون لجمال نباتاتها وروعة تنسيقها ورونق أجوائها. كيف يكون أولئك الذين يجرحون بقايا النباتات، والناجون من الأسماك، والمقاتلون من أجل البقاء من صنوف الطيور بموسيقى قبيحة، وألفاظ أقبح، وتصرفات مريعة، أن يكونوا من سلالة شادية وكمال الشناوي وعماد حمدي ومديحة يسري وغيرهم من فطاحل الفن الذين ترددوا على الحديقة لتصوير مشاهد أفلامهم المخلدة في تاريخ السينما والوجدان العربي؟
وعلى الرغم من جهود الترميم ومحاولات التحسين، إلا أن مقارنة صور حديقة الأورمان– قبل أن يصبح الشعب متدينًا بالفطرة غارقًا في "المحافظة" الشكلية متمرغًا في حفر "هل صليت على النبي اليوم؟" على الممتلكات العامة والمباني الأثرية والأشجار التاريخية بما آلت إليه في العام الـ18 من الألفية الثالثة كفيلة بإصابتنا باكتئاب مزمن وضغط مذهل.
ذهول يصيب كل ذي عقل لم يسلم نفسه للهسهس بمتابعة أخوات منتقبات يقزقزن اللب من تحت النقاب ويبصقن القشر بصقًا على النباتات من حولهن. صبية تتراوح أعمارهم بين التاسعة والـ12 على أقصى تقدير جاءوا خصيصًا لمتابعة أجساد الفتيات، و"تلقيح" الكلام هنا وهناك مع بعض من قطف لزهرة مثمرة، أو دهس لنبتة بازغة.
أما البحيرة التي كانت آية من آيات الجمال والروعة، فقد تحولت مقلبًا للقمامة. وعلى "كوبري زوزو" الخشبي (الذي سمي هكذا على اسم الراحلة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو") وقفت العائلات تأكل أكياس الشيبس والسندوتشات المغلفة والمياه الغازية، وتستقر البقايا والأوراق في عرض البحيرة!
لكن وسط العتمة الثقافية والظلمة الفكرية تبدو أمارات أمل ضئيلة. ففي إطار "معرض زهور الربيع"– ذلك الحدث الرائع السنوي- تجد أسرة بسيطة تحمل زرعة صبار صغيرة اشترتها لتوها بعشرة جنيهات بحرص شديد، أو سيدة خمسينية تتأمل زهور الـ"ديزي" والـ"بانسيه" لتتخير إحداها متخيلة إياها على شرفة غرفتها. إذن، مازالت لدينا بقايا من قدرة على تذوق بقايا من جمال.
هذه البقايا تكفي لإنقاذ من يمكن إنقاذه من أدمغتنا وأخلاقنا. قليل من جمال الطبيعة وروعة الفن قد تنقي الأرواح التي أثقلتها ضبابية التدين المزيف الذي صور القبح باعتباره واجباً دينياً يثاب عليه صاحبه، وأغرقتها غوغائية ثقافية جعلت من القبح فناً ومن العشوائية أسلوب حياة.
أيها القائمون على أمر مصر، أكثروا من مواطن الجمال علَّها تنقي الروح وتطهر العقل. واحموا هذا الجمال بذراع حديدية قوامها تطبيق القانون على الجميع بحسم وحزم. من يلقي قمامة أو يشوه جمالاً أو يعتبر البحيرة مقلب زبالة والحديقة مكانًا يجمع بين الإنسان والنفايات يدفع غرامة فورية، ومن يتحرش بأنثى يعاقب طبقًا للقانون، وهلم جرا. ولكن على من يطبق القانون أن يكون فاهماً له، مقتنعاً بجدواه، ذا عينين وجيبين لا تنتظر رشوة أو تطلب جباية. الوضع سيئ جدًا، لكنه أيضًا يحمل بعضًا من أمل.
إعلان