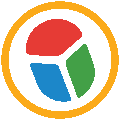- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة
تسجيل الدخول
أيهما أكثر جناية على الحضارة الإسلامية، وهي الجناية التي أعاقت تطور الفكر الإسلامي منذ القرن السادس الهجري، وكانت سببًا في صراع لم ينتهِ لليوم بين الفقهاء والفلاسفة والصوفية: هل هو حجة الإسلام الإمام الغزالي (505:420ﻫ) أم الفيلسوف أبوالوليد أحمد بن رشد (595:520ﻫ)؟!
أظن أن الإجابة عن هذا السؤال تكشف أبعاد قضية مهمة من قضايا تراثنا الإسلامي، وهي قضية تعارض النقل مع العقل، الشريعة مع الحقيقة، كما تكشف لنا جذور رفض الآخر والتكفير في حياتنا، وجذور الحرب المنظمة التي شُنت على الفلسفة في العالم الإسلامي، منذ القرن السادس الهجري بتأثير من أفكار الإمام الغزالي المعادية للفلسفة.
وإذا نظرنا إلى الإمام الغزالي من منظور فكري محايد نجده قد ارتكب جناية فادحة في حق الفكر الإسلامي، عندما مارس سياسة الإقصاء والاستبعاد لأصحاب الاتجاهات المخالفة له، وما يمثلونه من قناعات؛ لأن الإمام الغزالي بطبيعته القلقة غير المستقرة، وميله إلى الإفراط في كل شيء، قد هاجم في كتابه "تهافت الفلاسفة" العلوم العقلية، وكفر فلاسفة اليونان وأتباعهم من فلاسفة الإسلام، وكان نقده للأفكار الفلسفية موجهًا لهدم مذهب الفيلسوف اليوناني أرسطو، الذي أخذ به الفلاسفة المشائين المسلمين، وأهمهم الفارابي (260 – 339 هـ) وابن سينا (370 – 427 هـ)، الذين اعتبرهم الغزالي مرددين لأفكار أرسطو وناقلين للفلسفة اليونانية.
بعد ذلك تدخلت السياسة بضيق أفقها المعهود في هذا الخلاف الفكري، واستثمرت فيه لخدمة مصالحها، لأنها وجدت أنه يحقق أهدافها، ويحفظ لها استقرارها، ولهذا تبنت السلطات السياسية في أغلب العالم الإسلامي مذهب الإمام الغزالي وناصرته علي بقية المذاهب واضطهدت أصحابها.
وقد أصبح من المؤكد اليوم دور العامل السياسي في تدعيم ونشر مذهب الغزالي وإقصاء بقية المذاهب، من خلال الأدلة التاريخية التي تثبت علاقة الغزالي بالوزير "نظام الملك" وزير السلجوقيين، وهو الذي أسس المدارس الدينية التي عُرفت باسم "المدارس النظامية" بهدف نشر وتقوية المذهب الشافعي، والعقيدة الأشعرية، وتغليبهما على المذاهب الأخرى.
في هذا الصدد، يقول الدكتور عبد الأمير الأعسم في كتابه "الفيلسوف الغزالي.. إعادة تقويم لمنحى تطوره الروحي"، موضحًا أبعاد العلاقة الوطيدة التي ربطت الغزالي بالوزير نظام الملك: "إن نظام الملك السياسي وجد ضالته في شخص الغزالي الشاب الذكي الطموح، العارف بعلوم زمانه، ذي الأفكار المتجددة.. كان الغزالي في نظر نظام الملك الوسيلة التي يستطيع بواسطتها أن يجعل من هدفه حقيقة، ألا وهو أن يكتسح الشافعيون كل المذاهب الأخرى، وأنه لا مكان لعقيدة إلا للعقيدة الأشعرية، وبعد ذلك يمسك بزمام كل الأمور".
ولكن بعد رحيل الإمام الغزالي، كتب الفيلسوف ابن رشد في منتصف القرن السادس الهجري كتابه الشهير "تهافت التهافت" ليناقش ويبطل آراء الغزالي التي أوردها في كتابه "تهافت الفلاسفة"، وليُعيب عليه أنه ألف هذا الكتاب من أجل الجدل، لا من أجل الوصول للحقيقة. ودافع ابن رشد في كتابه عن العقل وعن الفلسفة كأداة صالحة للوصول للحقيقة، وهاجم خصوم الفلاسفة الذين يتهمونهم بالزندقة وجاهر كمعظم فلاسفة الإسلام السابقين، بما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، لكنه أكد في الوقت ذاته على نخبوية الفلسفة، وأنها أعلى غايات الإنسان، وقل من يستطيع أن يبلغ مستواها، ولهذا فإن الوحي النبوي يقوم مقامها تجاه العوام وبسطاء الناس.
إلا أن محاولة ابن رشد للانتصار للفلسفة، لم تُفلح في عودة الحياة إلى العلوم العقلية، ومن ثم بعث الحضارة الإسلامية من جديد؛ فقد تدخلت من جديد السلطة السياسية في الأندلس، وناصرت مذهب الغزالي على مذهب ابن رشد، وهنا كانت بداية محنة ابن رشد، وما حدث فيها من اضطهاده لشخصه، وحرق كتبه.
وجدير بالذكر أن ابن رشد لم يُضطهد وحده في الأندلس؛ فكثير من العلماء والأطباء والفقهاء والقضاة والشعراء قاسموا ابن رشد نكبته، لأنهم مشتغلون بالحكمة وعلوم الأوائل؛ وعلة ذلك أن أصحاب دولة الموحدين في الأندلس قد ارتبطوا بمذهب الغزالي مباشرة وتأثروا بأفكاره، وكان مؤسس دولتهم بأفريقيا يوسف بن تاشفين (400 -500 ه) من أكبر المؤيدين للإمام الغزالي.
والآن دعونا نتساءل: ماذا لو لم تتدخل السياسة بضيق أفقها وأهدافها البرجماتية في الصراع الفكري الذي دار بين الإمام الغزالي والفيلسوف ابن رشد، عندما ناصرت الغزالي باتجاهه الصوفي، واضطهدت ابن رشد باتجاهه العقلي؟
أظن أنه لو ظل الأمر في دائرة الخلاف والنقاش الفكري، بعيدًا عن السياسة، لربما التقى التصوف مع الفلسفة، واعترف كل منهم بالآخر وبحقه في الوجود، دون استبعاد أو إقصاء أو تكفير؛ فالفلسفة تُمثل البعد العقلي في الإسلام، والتصوف يُمثل البعد الروحي، وكل منهما ينبع من احتياج إنساني أصيل، ويمكنهما أن يتكاملا دون صدام؛ فتبدأ الفلسفة كما يبدأ التصوف بمُسلّمة الإيمان بالله والتأكيد على البعد المفارق والمتسامي للوجود الإنساني، ثم يسعيان معًا لخلق وتطوير منهج مميز للوصول للحقيقة، منهج يجمع بين الحدس والذوق الصوفي والتفكير والبرهان العقلي، ويدفع بالحضارة الإسلامية نحو الرقي والتقدم.
وما أشير إليه هنا يؤكده ويزيده وضوحًا الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل (1872-1970 م) في كتابه "التصوف والمنطق"، حيث رأى وحدة المتصوف مع رجل العلم تشكل أعلى مكانة مرموقة يمكن إنجازها في عالم الفكر؛ لأن هذا الانفعال (التصوف) هو المُلهم لأفضل ما في الإنسان.
وبناء على ذلك يمكن القول إن الجناية على الفكر الإسلامي التي أعاقت تطوره وازدهاره بعد القرن السادس الهجري، وأدت إلى تدهور الحضارة الإسلامية- يتحمل مسؤوليتها أربعة أطراف:
الطرف الأول: الإمام الغزالي الذي أخذ بمنطق حديث الفرقة الناجية- المشكوك في صحته عند الإمام ابن حزم والإمام العز بن عبدالسلام - وبالتالي فقد قال بتكفير الفلاسفة، واستبعد أي دور للعقل والنظر العقلي في الأمور الإيمانية.
الطرف الثاني: الفيلسوف ابن رشد الذي قال بنخبوية الفلسفة، وإن الوحي النبوي يقوم مقامها تجاه العوام وبسطاء الناس، كما أعجب إلي درجة الغلو بأرسطو وبالفلسفة اليونانية، دون أن يُدرك سياقها الحضاري والثقافي وظروف نشأتها، مما أوقعه علي نحو شبه كامل في قبضة الفلسفة اليونانية باستدلالاتها وميتافيزيقاها الخانقة.
الطرف الثالث: السلطات السياسية التي تبنت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، مذهب الإمام الغزالي وناصرته علي بقية المذاهب واضطهدت أصحابها، لأنها وجدت أن مذهب الغزالي يحقق أهدافها، ويحفظ لها استقرارها، بمنع الناس من التفكير، وترك أصحاب السلطة الدينية والسياسية يفكرون لهم.
أما الطرف الرابع: فيمثله جموع المشتغلين بالعلوم الدينية والفلسفية من زمن الإمام الغزالي وابن رشد إلي اليوم، وهم عندي الذين يتحملون النصيب الأكبر من تلك الجناية؛ لأنهم قاموا باستعادة هذا الصراع الفكري، وانحازوا لطرف مقابل الطرف الآخر، ولم يكتفوا بخصوم الماضي، بل راحوا يبحثون عن خصوم لهم في الحاضر من أصحاب الاتجاهات الأخرى، ليدخلوا معهم في معارك تستهلك الجهد والوقت، وتعمق الخلاف والعداء بين المذاهب، وقد كان الأجدى بهم أن يبحثوا عن مواطن الالتقاء والتوافق والتكامل، بدلًا من البحث عن مواطن الخلاف وإثارة والصراع.
واعتقد أن هذا هو الدرس الذي يجب أن يستوعبه اليوم شباب المشتغلين بالعلوم الدينية والإنسانية، الذين يطمحون لأن يكون لهم دور في صياغة مستقبل أوطانهم وأمتهم، عن طريق الفهم الواعي لتراثهم وماضيهم، والرؤية الواضحة لواقعهم.
وعن طريق القناعة الكاملة بأن العقل يجب ألا يعادي الإيمان، والإيمان الحقيقي يجب ألا يعادى العقل ولا الفلسفة بمنهجها القائم علي التحليل والنفاذ إلى ما وراء الأشياء والظواهر الخادعة، وأنهما معاً (العقل والإيمان) يمثلان حجر الزاوية في معركتنا لتحرير الإنسان المعاصر، وتخليصه من كل القوى التي تحاول تشتيته واستلابه روحًا وعقلًا وجسدًا.
إعلان