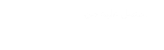وصية نبوية في ملازمة التقوى والاستغفار
وصية نبوية في ملازمة التقوى والاستغفار
ما أحوجنا إلى وصايا نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإلى فهْم هديه والسير على ما وجَّهنا إليه، فقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾.. [النور : 54].
أيها الإخوة الكرام، أعيش وإياكم في هذه الدقائق وصيةً كريمةً أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه؛ حيث قال: قلت: يا رسول الله، أوصني، فقال: ((عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل شجرٍ، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عمِلت من سوءٍ، فأحدِث لله فيه توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية))؛ رواه الإمام الطبراني رحمه الله، وحسَّنه العلامة الألباني عليه رحمة الله.
هذه الوصية الكريمة التي تطلَّع إليها معاذ رضي الله عنه، وقد كان من هدْي الصحابة رضي الله عنهم - وبخاصةٍ مَن يَفِد إليه عليه الصلاة والسلام - أن يتطلَّعوا إلى وصايا كريمة، فكثيرًا ما عُرِض عليه - عليه الصلاة والسلام - القول: أوصِني يا رسول الله، وكان من جملة ذلك ما طلبه هذا الصحابي الكريم، ومعاذ من المعلوم رُتبته في الصحابة في العلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موصيًا: ((عليك بتقوى الله ما استطعت))، وهذا يُبين شدة حاجة الإنسان إلى تقوى الله جل وعلا، كيف وهي وصية ربنا سبحانه لعموم عباده في كتاب العزيز، فقد تكرَّرت وصية الله بالتقوى في مواضع عديدة، وقد قال العلماء في معنى التقوى: أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية؛ بفعل أوامره، وترْك نواهيه.
وقال بعض العلماء أيضًا وهو مؤدٍّ لهذا المعنى: إن المعنى ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يَفقدك حيث أمرَك، والإنسان بحاجةٍ إلى ملازمة هذا الأمر، وبخاصةٍ مع تسلُّط الشيطان، وأيضًا ما يكون من إصرار الهوى والنفس الأمَّارة بالسوء، وقد جاءت هذه الوصية أيضًا في موضعٍ آخرَ حينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا وهو خارجٌ إلى اليمن؛ حيث أوصاه بمثل هذه الوصية، أو بنحو منها، أو على قربٍ من ألفاظها، وقال عليه الصلاة والسلام: ((اتَّق الله حيثما كنت))، فالإنسان لا ينفك عن حاجته لتقوى الله سبحانه في أي لحظةٍ من زمانٍ أو مكان، عليك بتقوى الله ما استطعت، ومما يُعين الإنسان على أن يكون ملازمًا لهذه الوصية أن يَستشعر مراقبة الله تعالى، فإن المؤمن الذي استقر في قلبه إيمانه بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وأن الله يسمعه ويراه، وأن الله تعالى مطلعٌ على سره ونجواه، وأنه جل وعلا قادرٌ عليه؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾.. [ق: 16].
إذا استشعر المرء هذه الأمور، فإن هذا يُعينه كثيرًا على أن يكون ملازمًا لطاعة الله جل وعلا، مبتعدًا عن معصيته، وإنما يُصاب أحدنا حيث يصاب بالذنب والخطيئة، حينما تناله الغفلة، ويبعد عنه استشعار المراقبة، فإن الإنسان حينئذ يَنزلق فيما يُسخط الله جل وعلا؛ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النُّهبة حينما ينتهبها وهو مؤمن)).
والمعنى كما جاء مفصلًا أن الإنسان الذي يقع في هذه الأمور العظام، وفيما يُسخط الملك العلام، إنما هو بُعد المراقبة عنه، واستيلاء الغفلة على قلبه، ولذلك فإن الإيمان حينئذ يكون مُنخلعًا عنه، كما يخلع الإنسان الثوب، ويفسخه عن نفسه؛ ولذلك يزول عنه في هذه اللحظات الإيمان الذي يمنعه ويردعه عن أن يقترف ما يُغضب الله جل وعلا، ولكم أن تتأملوا في حال تلك المرأة التي اضطُرَّت إلى المال، فسألت رجلًا فلم يزَل يُراودها حتى إذا خلا بها، قالت: والله إني لم أعمل هذا العمل في حياتي يومًا قط، فلا تَفضَحني، ولا تُطلِعْ علينا أحدًا، فقال: ما تركت من بابٍ من بيننا وبين الناس إلا أغلقته، قالت: لكن بقِي بابٌ لم تُغلقه وهو الباب الذي بيننا وبين الله، فاستحضر الإيمان وارتعدت فرائسه، وقام عن الإثم والخطيئة بعد أن كان مواجِهًا لها، وموشكًا على اقترافها، وإنما ينفر الإنسان عن مثل هذه الخطايا بعد قدرته عليها ودعاء النفس والهوى إليها، إنما ينفك عنها ويبتعد إذا استحضر مراقبة الله جل وعلا، والمقصود أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي خير الزاد للإنسان، ففيها فلاحه في الدنيا والآخرة، وفيها قُربه من ربه جل وعلا.
ومن وصل إلى حقيقة التقوى، فإنه ينال عند الله منزلةً عُليا، ويكون عند الله سبحانه وتعالى وليًّا، ألم تتأمَّلوا في قول ربنا سبحانه في شأن مَن هذه منزلته، ومَن يراقب الله تعالى حقَّ المراقبة: (مَن عادى لي وليًّا، فقد آذنتُه بالحرب)، إلى آخر الحديث القدسي، وفيه قول ربنا جل وعلا: (ولئن سألني لأُعطِيَنَّه، ولئن استعاذني لأُعِيذَنَّه))، إلى آخر الحديث القدسي.
فيبلغ الإنسان هذه المنزلة العالية، فينال - مِن انشراح الصدر، وطيب الحياة، وسرور الخاطر - ما لا يمكن وصفه، وما لا يمكن تحصيله بكنوز الدنيا.
إنها الطُّمَأنينة التي يُنزلها الله في قلب عبده في حال حياته ومراحلها كلها، وفي حال لحظات انتقاله من هذه الحياة الدنيا؛ حيث يقول ربنا جل وعلا مبينًا هذه المنة العظمى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ .. [فصلت: 30 - 32].
فهذا هو الركن الأول من هذه الوصية العظيمة، وعليه يُبنى ما بعده؛ ولذلك جاء عقب هذا الركن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (واذكر الله عند كل حجرٍ وشجر))، عند كل حجر، قال العلماء: المراد بذلك السفر، وعند كل شجر المراد به الحضر، وقيل: أُريدَ به الشدة والرخاء، فالحجر عبارة عن الجدب، والشجر كناية عن الخصب، والأمر أعم من ذلك، وهو أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا عند كل حجرٍ وشجر، وعند كل لحظةٍ، وفي كل مكان، فالمقصود هو ملازمة ذكر الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لمعاذ وللمسلمين عمومًا بعد أن أوصى بالتقوى: ((اذكر الله جل وعلا عند كل حجرٍ وشجر)) - يريد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يُدرب المسلم على تحقيق التقوى؛ إذ إن التقوى إنما تتحقق حينما يستحضر الإنسان ذِكر ربه جل وعلا؛ لأن الغافل الذي لا يذكر الله، يستولي عليه الشيطان، ويكون على قلبه الران الذي يمنعه من استشعار عِظَم الآثام والخطايا، ويَجعله مندفعًا إليها بلا مراقبة، لكن المؤمن الذي يذكر الله تعالى في كل لحظاته، يُدرك أن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا تَخفى عليه خافية، الذي أحاط بكل شيء علمًا - أنه جل وعلا مطلع عليه، فحينئذ يستحيي من ربه جل وعلا أن يَقترف ما يُغضبه وهو يتقلَّب في نَعمائه، فمهما نظر فهو على نعمة من ربه جل وعلا، فكيف يعصيه؟ وكيف يُسخطه؟
ألا ترون أيها الأخوة الكرام ولله المثل الأعلى لو أن إنسانًا ضيَّفه ملك أو أمير، أو رئيس أو صديق، أو غيرهم، ضيَّفه في داره، وكان قد أشرع في هذه الدار من الكاميرات المراقِبة له في كل مجلسٍ وكل ممر وحجرة، قد أشرع هذه الكاميرات التي تراقب كل شيء، هل يمكن - وهو الذي يحل في هذا المكان على مَن ضيَّفه - أن يكسر شيئًا، أو أن نقول: لو أن أمامه مِن قطعٍ ثمينة من ذهب، أو رزم من مال على طاولةٍ أمامه، هل يمكن أن تمتد يده إلى قطعةٍ من هذه القطع، ولو صغرت وعظُم ثمنها؛ ليخفيها في جيبه وهو يشاهد هذه الكاميرات التي تحيط به من كل جانب، فالأمر حينئذ سيكون بعيدًا إلى حد كبير بالنظر إلى أنه في دار ضُيِّف فيها وأُكرِم، وبالنظر أيضًا إلى أنه مُراقَبٌ من قِبَل هذه الكاميرات، فكيف والإنسان ولله المثل الأعلى مُحاط بما هو أعظم من ذلك، فالذي في تلك الدار أو في ذلك القصر، ربما شاهد قطعةً سقَطت على الأرض، فرفعها أو وجدها في ممر، فأخذها معه؛ ليعيدها إلى مكانها، لكن الكاميرا لا تُفرِّق بين هذا الذي حملها ليعيدها إلى مكانها، وبين مَن أراد أن يسرقها؛ لأنها لا تدري ما الذي في قلب هذا الإنسان، بخلاف ما يكون من مراقبة الله جل وعلا الذي كما تقدَّم في الآية الكريمة يَعلم السر وأخفى، فالله جل وعلا مطلعٌ على ما يريده هذا العبد، فالله يُنعم عليه وقد أضمر في قلبه هذا الإنسان من عصيان الله جل وعلا ما هو مطلعٌ عليه، وهذا أيها الأخوة في الله ملازمة ذكر الله جل وعلا، واستحضار هذه المراقبة التي تُعين الإنسان على تحقيق التقوى، وتُباعده عن الإثم والمعاصي، وإنما يتفارَق الناس في بُعدهم عن المعاصي والآثام، أو تلطُّخهم بها، بحسب ذكرهم لله جل وعلا، هل شاهدتم أحدًا تمتد يده إلى كأس الخمر، فيقول: بسم الله، الحمد الله الذي رزقني ذلك، ثم يشربها، محالٌ هذا الأمر، لكنه في تلك اللحظات يكون قد استولت عليه الغفلة، وهكذا في كل إثمٍ وخطيئة، لا يمكن أن يكون داخل البار الذي يتوجه إليها، يقدِّم رجله اليمين، ويذكر الله ويسأله من فضله، كالذي يصنع عندما يريد دخول المسجد، محالٌ هذا في العقول الصحيحة مُحال، ولكنها الغفلة التي متى تسلطت على الواحد منا، فإنها تُهلكه وتمكِّن عدوه منه، وتجعل الشيطان يتسلَّط عليه في تلك اللحظات؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام - وهو النبي الكريم المؤيَّد من ربه العليم -: ((إنه ليُغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة)).
إنه ليغان على قلبي؛ يعني: ما يكون من تسلُّط الشيطان، الذي يريد أن يغوي بني آدم جميعًا، ومنهم نبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم؛ ولذا قال: وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة، وهو الذي غفَر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، لكنه يُبين لنا الحل في مدافعة هذا الغيم وهذا التسلط من الشيطان، وهو ذكر الله جل وعلا والاستغفار، فالملازم لذكر الله بعيد عن الآثام، الملازم للاستغفار موفق للخيرات، مباعد عن الشرور والآثام، بخلاف ذلك القلب الذي لم يَزَل صاحبه متواليًا في الآثام والخطايا؛ حتى يكون قلبه محطةً يَفِد إليها الشيطان متى ما أراد، لا يمنعه مانعٌ، ولا يرده رادٌّ؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ((مثل الذي يذكر ربَّه، والذي لا يذكره، كمثل الحي والميت)).
فالذي يذكر الله تعالى حيٌّ، مُدافَع عنه من تسلُّط الشيطان، بخلاف هذا الغافل الذي تمكَّن منه الشيطان متى ما أراد في كل لحظةٍ وحين.
أعاذني الله وإياكم من تسلُّط شياطين الجن والإنس، ووفَّقنا جميعًا للخيرات، بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.
فهذه الوصية النبوية الكريمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجرٍ وشجر، وما عمِلت من سوءٍ، فأحدث لله فيه توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية)).
لَمَّا كان الإنسان غير معصومٍ ولا ينفك عن الزلل والخطأ؛ إذ لم يَسْلَم ولم يُعصَم إلا الأنبياء والرسل فيما يُبلغونه عن ربهم تبارك وتعالى، فإن الإنسان معرَّض للزَّلل مهما عظُم إيمانه، ومهما علَت درجاته؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام - فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسندٍ جيد -: ((كل بني آدم خطَّاء، وخير الخطائين التوابون)).
فأي أحدٍ من بني آدم لا ينفك عن خطيئته وذنبه، ولكنهم يتفاوَتون في الأَوْبة إلى الله جل وعلا، وسرعة الرجوع إليه سبحانه.
وهذا من حِكَم الله جل وعلا في خلْقه أن جعلهم في هذه الدار - دار الاختبار والامتحان - ويوضِّح هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لو لم تُذنبوا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يُذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم)).
فأسماء الله جل وعلا الغفور والرحيم، وصفاته جل وعلا من المغفرة والرحمة والعفو، إنما تظهر آثارها في هؤلاء العباد الذين يُبتلَون بالذنوب والآثام، ثم يعودون إلى حِياض التوبة، ويغتسلون بماء الاستغفار، فيدخلون على ربهم جل وعلا وقد تطهَّروا من كل هذه الأقذار.
فقوله صلى الله عليه وسلم: ((وما عمِلت من سوءٍ، فأحدث لله فيه توبة، يدل على الأسلوب في معالجة الذنوب والخطايا، وهو المبادرة إلى التوبة لله جل وعلا، والله سبحانه قد فتح هذا الباب لعباده، وأحبَّه منهم، ورغَّبهم فيه، وقد تكاثَرت النصوص في كتاب الله تعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في التوبة وبيان حبيب آثارها وكريم عاقبتها؛ كما في قول الله جل وعلا: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.. [الزمر: 53].
بل إن الله تعالى قد جعل من فضائل التائب المقبل على ربه، ما لا يخطر على البال، ولا يحده الخيال؛ حيث نقرأ قول ربنا سبحانه في شأن عباد الله المؤمنين الذين لا يَقترفون آثامًا ذكرها الله، ولكن مَن تاب فإن له المنزلة العالية؛ حيث يقول سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾.. [الفرقان: 68 - 70].
فتأمَّلوا أيها الأخوة في هذا الكرم الإلهي وهو أن السيئات تبدَّل إلى حسنات، وهذا من إكرام الله تعالى لعبده المؤمن الذي صدق في التوبة، صدق في إقباله على ربه جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يُبدِّل سيئاته حسنات، وإنما يكون هذا للذين صدقوا مع الله، صدقوا في توبتهم، إنما يكون ذلك للذين إذا تذكَّروا ذنبًا أو خطيئة، بلغ بهم الحياء مبلغَه، كيف يعصون مَن أنعم عليهم؟ كيف يعصون من هو مطلع عليهم؟ كيف استرخصت وتساهَلت نفوسهم في إثم وخطيئة تُوجَّه ويُبارز بها المنعم المتفضل جل وعلا؟! لكنها مِنة الله ورحمته وإحسانه، نسأله جميعًا المزيد من فضله.
وتأمَّلوا أيها الأخوة في تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أسلوب التوبة، وهو السر بالسر، والعلانية بالعلانية؛ قال العلماء: السر يعني: فعل القلب، والعلانية: المعني بذلك فِعل الجوارح، فيقابل كل شيءٍ بمثله.
فمن أخطأ في سر ولم يَستعلن بذلك، فليتب إلى الله سرًّا، ومن استعلن بذنبٍ أو خطيئة، فيجب عليه أن يُعلن أنه تاب من هذا الذنب والخطيئة، فمثلًا بعض الناس آثامهم وذنوبهم مُعلنة، مُشهرة مُجاهَر بها؛ كالذين يغنون على المسارح، أو الذين يتعاطون الآثام ومقدمات الفواحش؛ كالمغنيين والفنانين، وأمثالهم من الممثلين والممثلات، فمثل هؤلاء توبتهم يجب أن تكون علانية، وأنهم تركوا هذا الطريق الخاطئ، وهكذا لو أن إنسانًا يروِّج مخدرات، وعُرِف بذلك واشتَهر، فإنه يعلن أنه رجع عن هذا الطريق، أو أن إنسانًا قد تلبَّس بفكرٍ ضال، ومسلكٍ منحرف في تكفير المسلمين والخروج على وُلاتهم، فيجب عليه أنه كما أعلن ذلك ابتداءً أن يُعلنه انتهاءً.
السر بالسر والعلانية بالعلانية؛ لأن الذنب والإثم والخطيئة الذي يفعله الإنسان جهرًا، قد يغتر به كثيرٌ من الناس ويُتابعونه ويُقلدونه، فإذا رجع سرًّا ولم يُعلن ذلك، ربما بقِي مَن تأثَّر به، وقلَّده على نفس المسلك الخاطئ، لكنه إذا أعلن وقال: إني رجعت عن هذا الطريق لخطئه وإثمه، فإن هذا يؤثر في أولئك الأتباع الذين تأثَّروا به، وهذا أمرٌ مشاهَد؛ إذ إن الذين يُعلنون توبتهم بعد أن أعلنوا آثامهم، يتأثَّر بهم الناس، فيُسرعون في توبتهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا!
وبعدُ أيها الأخوة الكرام، فهذه الوصية العظيمة التي قال فيها معاذٌ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال له: ((عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوءٍ، فأحدث لله فيه توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية))؛ رواه الطبراني رحمه الله.
هذه الوصية الكريمة ينبغي أن تكون حاضرةً في كل حين؛ حتى ينال الإنسان بركاتها، ويعمل بمقتضاها، فيفوز في الآخرة والأولى.
ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾.. [الأحزاب : 56].
اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذِل الكفر والكافرين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم وفِّق وُلاة أمورنا لما تحبه وترضاه.
اللهم وفِّق ولاة أمورنا لكل خير فيما فيه نفْع العباد والبلاد يا رب العالمين.
اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعِد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين.
اللهم أصلح عمومَ ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمةً على رعاياهم يا رب العالمين.
اللهم احقِن دماء المسلمين في كل مكان.
اللهم ارحَم ضَعْف إخواننا وفِتنتهم في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن.
اللهم احقن دماءهم.
اللهم أمِّن خوفهم.
اللهم ارفع الظلم عنهم يا رب العالمين.
اللهم اجمعهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أبعد عنهم كل ماكرٍ ومعتدٍ وآثمٍ يا رب العالمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين.
اللهم اكْفِهم شرور أعدائهم، وعليك بالمحتلين لبلاد المسلمين، وأخرجِهم منها أذلة صاغرين يا رب العالمين.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربَّونا صغارًا.
اللهم بمنِّك وفضلك لا تدَع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دَينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيتَه برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان ربك ربِّ العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.
المصدر: موقع معرفة الله
فيديو قد يعجبك: